العدد العاشر
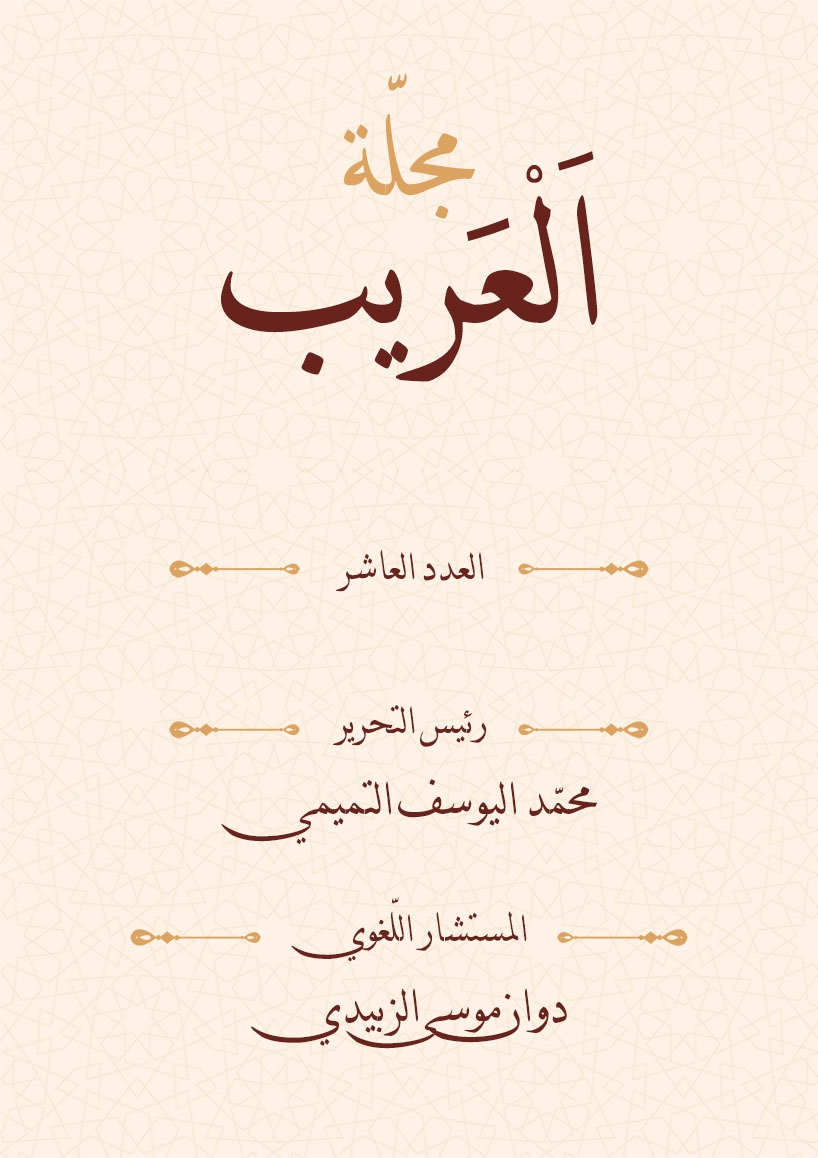
أبواب المجلة
افتتاحيّة
تضمن العدد العاشر من مجلة "تبين" جملةً من الدراسات والبحوث والمقالات المحكّمة الآتية:"كلمات أعجمية في القرآن الادعاء والرد،جموع الكثرة في القرآن الكريم أكثر من أربعين جمعا،والسلام في لغة الحديث الشريف،ودور الرسول صلى الله عليه وسلم في إرساء قواعد الأمن والسلام في العالمين...
بلسان مبين
- الكلمات الأعجمية في القرآن ( الادّعاء والردّ)
تساؤلات حول الإعجاز اللغوي مع وجود أخطاء لغوية من نحو، وصرف. فما رأيك في قول القرآن أنه أنزل بلسان عربي مبين؟
الإجابة: الواقع أن هناك آيات قرآنية عديدة تؤكد أنه: قرآن بلسان عربي مبين، منها:
(1) [سورة يوسف 12: 2] "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"
(2) [سورة طه 20: 113] "وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا .."
(3) [سورة الزمر 39: 28] "قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون"
(4) [سورة فصلت 41: 3] "كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون"
(5) [سورة الشورى 42: 7] "وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها .."
(6) [سورة الزخرف 43: 3] "إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"
(7) [سورة الأحقاف 46: 12] "وهذا كتاب مصدق [لكتاب موسى] لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا.."
(8) [سورة الشعراء 26: 193و195] "نزل به الروح الأمين .. بلسان عربي مبين"
(9) (سورة النحل 16: 103) "وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ"
أجمع المفسرون على معنى ذلك "أَيْ أَفْصَح مَا يَكُون مِنْ الْعَرَبِيَّة"
إذاً أنت مقتنع أنه بلسان عربي فصيح؟
الإجابة: هذا ما يقولونه، ولكن لي تساؤلات على هذا.
ما هذه التساؤلات؟
الإجابة: قرأت في دائرة المعارف الإسلامية، وغيرها من المراجع الإسلامية أن بالقرآن ما يزيد عن 275 كلمة أعجمية: أي غير عربية مأخوذة من لغات أخرى فكيف يكون القرآن بلسان عربي مبين؟ ولهذا أرجو من حضرات الأفاضل شيوخ الإسلام المتخصصين في اللغة أن يعللوا لنا ذلك؟ هل يمكن أن تفيدنا بما قالته دائرة المعارف الإسلامية في ذلك؟
الإجابة: جاء في دائرة المعارف الإسلامية (ج 26 ص 8222ـ 8224)
تحت عنوان "الكلمات الدخيلة" ما يلي:
(1) لم يجد المفسرون الأوائل حرجا في الإقرار بوجود عدد كبير من الكلمات الدخيلة (الأعجمية) في القرآن، أو في مناقشتها.
(2) وقد جاء في الأثر أن ابن عباس، ومن لفَّ لفَّه كانوا يبدون اهتماما خاصا برصد أصولها وتحديد معانيها.
(3) لكنه بعد ظهورالمبدأ القائل بأن القرآن قديم، ويتسم بالكمال، اتجه عدد من الفقهاء وعلماء الإلهيات، مثل الإمام الشافعي (ت205 هـ) إلى الاعتقاد بأن لغة القرآن عربية نقية، ومن ثم إلى إنكار وجود أي كلمات معارة من لغات أخرى.
(4) ولكنّ عددا من كبار علماء اللغة مثل أبي عبيد (ت224 هـ) لم يكفوا عن القول بوجود كلمات دخيلة (أعجمية) في القرآن.
(5) وهناك عدد من الباحثين قد تحرروا تماما من الاعتبارات الدينية في بحث هذا الموضوع مثل السيوطي (ت911هـ) الذي أبدى اهتماما خاصا بالكلمات الدخيلة في القرآن، إذ يخصص فصلا في كتابه "الاتقان":
1ـ للكلمات التي ليست بلغة الحجاز (ج1 ص133ـ135)،
2ـ وفصلا للكلمات التي ليست بلغة العرب (ج1 ص 135ـ141).
(6) وتضيف الموسوعة أنه في دراسة مستقلة (للمتوكلي)، يقدم تصنيفا لعدد كبير من الألفاظ باعتبارها كلمات مستعارة من اللغة الأثيوبية، والفارسية، واليونانية، والهندية، والسريانية، والعبرية، والنبطية، والقبطية، والبربرية.
تساؤلات حول الإعجاز اللغوي مع وجود أخطاء لغوية من نحو، وصرف. فما رأيك في قول القرآن أنه أنزل بلسان عربي مبين؟
الإجابة: الواقع أن هناك آيات قرآنية عديدة تؤكد أنه: قرآن بلسان عربي مبين، منها:
(1) [سورة يوسف 12: 2] "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"
(2) [سورة طه 20: 113] "وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا .."
(3) [سورة الزمر 39: 28] "قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون"
(4) [سورة فصلت 41: 3] "كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون"
(5) [سورة الشورى 42: 7] "وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها .."
(6) [سورة الزخرف 43: 3] "إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"
(7) [سورة الأحقاف 46: 12] "وهذا كتاب مصدق [لكتاب موسى] لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا.."
(8) [سورة الشعراء 26: 193و195] "نزل به الروح الأمين .. بلسان عربي مبين"
(9) (سورة النحل 16: 103) "وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ"
أجمع المفسرون على معنى ذلك "أَيْ أَفْصَح مَا يَكُون مِنْ الْعَرَبِيَّة"
إذاً أنت مقتنع أنه بلسان عربي فصيح؟
الإجابة: هذا ما يقولونه، ولكن لي تساؤلات على هذا.
ما هذه التساؤلات؟
الإجابة: قرأت في دائرة المعارف الإسلامية، وغيرها من المراجع الإسلامية أن بالقرآن ما يزيد عن 275 كلمة أعجمية: أي غير عربية مأخوذة من لغات أخرى فكيف يكون القرآن بلسان عربي مبين؟ ولهذا أرجو من حضرات الأفاضل شيوخ الإسلام المتخصصين في اللغة أن يعللوا لنا ذلك؟ هل يمكن أن تفيدنا بما قالته دائرة المعارف الإسلامية في ذلك؟
الإجابة: جاء في دائرة المعارف الإسلامية (ج 26 ص 8222ـ 8224)
تحت عنوان "الكلمات الدخيلة" ما يلي:
(1) لم يجد المفسرون الأوائل حرجا في الإقرار بوجود عدد كبير من الكلمات الدخيلة (الأعجمية) في القرآن، أو في مناقشتها.
(2) وقد جاء في الأثر أن ابن عباس، ومن لفَّ لفَّه كانوا يبدون اهتماما خاصا برصد أصولها وتحديد معانيها.
(3) لكنه بعد ظهورالمبدأ القائل بأن القرآن قديم، ويتسم بالكمال، اتجه عدد من الفقهاء وعلماء الإلهيات، مثل الإمام الشافعي (ت205 هـ) إلى الاعتقاد بأن لغة القرآن عربية نقية، ومن ثم إلى إنكار وجود أي كلمات معارة من لغات أخرى.
(4) ولكنّ عددا من كبار علماء اللغة مثل أبي عبيد (ت224 هـ) لم يكفوا عن القول بوجود كلمات دخيلة (أعجمية) في القرآن.
(5) وهناك عدد من الباحثين قد تحرروا تماما من الاعتبارات الدينية في بحث هذا الموضوع مثل السيوطي (ت911هـ) الذي أبدى اهتماما خاصا بالكلمات الدخيلة في القرآن، إذ يخصص فصلا في كتابه "الاتقان":
1ـ للكلمات التي ليست بلغة الحجاز (ج1 ص133ـ135)،
2ـ وفصلا للكلمات التي ليست بلغة العرب (ج1 ص 135ـ141).
(6) وتضيف الموسوعة أنه في دراسة مستقلة (للمتوكلي)، يقدم تصنيفا لعدد كبير من الألفاظ باعتبارها كلمات مستعارة من اللغة الأثيوبية، والفارسية، واليونانية، والهندية، والسريانية، والعبرية، والنبطية، والقبطية، والبربرية.
(7) وتورد دائرة المعارف الإسلامية أمثلة ذكرها السيوطي عن العناصر الدخيلة في ألفاظ القرآن إذ قال: "الكلمات التي تعدّ غير عربية على الإطلاق، ومن المحال ردها إلى جذور عربية مثل:
1ـ استبرق (الديباج الغليظ)
2ـ الزنجبيل.
3ـ الفردوس.
(8) وتذكر دائرة المعارف الإسلامية أن هناك نحو 275 كلمة بخلاف أسماء الأعلام عدّها العلماء كلمات أجنبية.
هذه معلومات خطرة للغاية. ولكن هل يمكن أن تذكر لنا بعض الأمثلة من هذه الكلمات الأعجمية بالسور التي ذكرت فيها؟
الإجابة: نعم شيء خطر جدا خاصة بمقارنته بما يقال: إنه بلسان عربي مبين. أمّا عن الأمثلة ففي "تأريخ القرآن" للشيخ إبراهيم الأبياري (طبعة دار الكتاب المصري بالقاهرة سنة1981م ص 190)
أورَد بعض الأمثلة للألفاظ الأعجمية في القرآن: (وأشار إلى كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي [ج1 ص 288]، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1 ص139)
الكلمة الأعجمية، ولغتها الأصلية، ومعناها بالعربية، وموقها في السور القرآنية؟
الإجابة:
الكلمة الأعجمية لغتها الأصلية معناها السورة
1- الطور سريانية الجبل البقرة2: 63 وغيرها "
2- طفِقا رومية قصدا الأعراف7: 22 "
3- الرقيم رومية اللوح الكهف18: 9 "
4- هدنا عبرانية تُبْنا الأعراف7: 156 " "
5- طه عبرانية طأْ يا رَجُل سورة طه20: 1 " "
6-سينين عبرانية حسن التين95: 2
7-السجل فارسية الكتاب الأنبياء21: 104
8-الاستبرق فارسية الغليظ الدخان44: 53
9-السندس هندية الرقيق من الستر الدخان44: 53 "
10- السِريّ يونانية النهر الصغير مريم19: 24
11- المشكاة حبشية الكوة النور24: 35 "
12-الدري حبشية المضيء النور24: 35 "
13-ناشئة الليل حبشية قيام من الليل المزمل73: 6 "
14-كِفْلين حبشية ضعفين الحديد57: 28 "
15-القَسْوَرَة حبشية الأسد المدثر74: 51 "
16-الملة الأخرى قبطية الأولى سورة ص38: 7 "
17-وراءهم قبطية أمامهم الكهف18: 79)
18-بطائنها قبطية ظواهرها الرحمن55: 54 "
19-أباريق فارسية أواني الواقعة56: 18
20-إنجيل يونانية بشارة آل عمران3: 48
21-تابوت قبطية صندوق البقرة2: 247
22-جهنم عبرية النار الأنفال8: 36
23-زكاة عبرية حصة من المال البقرة2: 110
24-زنجبيل بهلوية نبات الإنسان76: 17
25-سجَّيل بهلوية الطين المتحجر الفيل105: 4
26-سرادق فارسية الفسطاط الكهف18:29
27-سورة سريانية فص التوبة9: 124
28-طاغوت حبشية الأنداد البقرة2: 257
29-فردوس بهلوية البستان الكهف18: 107
30-ماعون عبرية القِدْر الماعون107: 7
من ضمن الشبهات التي يتناقلها أعداء الاسلام وممن يتمنون أن يجدوا فيه خطأ أو مدخلا ليس منيعا ليدخلوا إلى الإسلام منه وينخروا فيه كنخر السوس , لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين ومنهجه ومصدريه من الكتاب والسنة ولله الحمد ومن هذه الشبهات , شبهة احتواء القرآن على ألفاظ غير عربية .وقد تحدث العلماء قديماً وحديثاً عن ردّ هذه الشبهة التي استند أصحابها إلى آيات كريمة تدل على نزول القرآن الكريم باللغة العربية، منها:
قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ } [النحل103]، وقوله: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ{193} عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ{194} بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ{195} [الشعراء]، وقوله تعالى: {قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } [الزمر28].
لكنَّ أعداءَ الإسلام ومثيري الشبهات والشكوك حول النص القرآني قالوا إن هناك بعض الكلمات الموجودة في القرآن الكريم، ليست من لغة العرب، وهذا يتناقض مع النصوص القرآنية الدالّة على نزول القرآن بلسان العرب.
وقد ذكر الأستاذ جمال الشرباتي بعض الكلمات التي يتخذونها أساساً لشبهتهم، وأذكر كذلك:فرعون، فردوس، أباريق، إبراهيم، جهنم، ماروت، هاروت، سرادق، زنجبيل، طاغوت، ماعون.... وغيرها.
وفي هذا الموضوع ألّف السيوطي (ت911هـ) كتاباً سماه: (المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب)، جمع فيه 129 لفظاً معرّباً، نظمها في قوله:
وَزِدتُ ياسينُ وَالرَحمَنُ مَع مَلَكو *** تٍ ثُمَّ سينينَ شَطرَ البَيتِ مَشهورُ
ثُـمَّ الصِـراطِ وَدُرِّيٍّ يَحـورُ وَمُـر *** جـانٌ أَليـمٌ مَــعَ القِنـطـارِ مَـذكـورُ
وَراعِنـا طَفِقـا هُدنـا اِبلَـعـي وَوَرا *** ءَ وَالأَرائِــكُ وَالأَكــوابُ مَـأثـورُ
هـودٌ وَقِسـطٌ وَكُفـرٌ رَمـزَهُ سَـقَـرٌ *** هَونٌ يَصُدّونَ وَالمَنساةُ مَسطـورُ
شَهرٌ مَجـوسٌ وَأَقفـالُ يَهـودُ حَـوا *** رِيّــونَ كَـنـزٌ وَسَـجّـيـنٌ وَتَثـبـيـرُ
بَـعـيـرُ آزَرُ حـــوبٌ وَردَةٌ عَـــرِمٌ *** إِلٌّ وَمِـن تَحتِهـا عَبَّـدتَ وَالصـورُ
وَلِينَـةٌ فومُـهـا رَهــوٌ وَأَخـلَـدُ مَــز *** جــاةٌ وَسَـيِّـدُهـا الـقَـيّـومُ مَـوفــورُ
وَقُـمَّـلٌ ثُــمَّ أَسـفــارٌ عَـنــى كُـتُـبـاً *** وَسُـجَّــداً ثُــــمَّ رِبِّــيّــونَ تَـكـثـيـرُ
وَحِطَّةٌ وَطَوى وَالـرِسُّ نـونُ كَـذا *** عَـدنٌ وَمُنفَطِـرُ الأَسبـاطُ مَـذكـورُ
مِسكٌ أَباريـقُ ياقـوتٌ رَووا فَهُنـا *** ما فاتَ مِن عَدَدِ الأِلفاظِ مَحصورُ
وَبَعضُهُم عَدَّ الأولى مَـع بَطائِنُهـا *** وَالآخِرَةَ لِمعاني الضِـدِّ مَقصـورُ
وَمـــا سُـكـوتِـيَ عَـــن آنٍ وَآنِـيــةٍ *** سيـنـا أَوابِ وَالمـرقـومُ تَقـصـيـرُ
وَلا بِأَيدي وَمـا يَتلـوهُ مِـن عَبَـسٍ *** لِأَنِّـهـا مَــعَ مـــا قَـدَّمــتُ تَـكـريـر
وهذه الألفاظ الواردة في المنظومة السابقة كانت زيادة على ما نظمه الإمام ابن السبكي:
السَلسَبيـلُ وَطَــهَ كُــوِّرَت بِـيَـعٌ *** رومٌ وَطوبى وَسِجّيـلٌ وَكافـورُ
وَالزَنجَبيلُ وَمِشكاةٌ سَرادِقٌ مَع *** اِستَبرَقٍ صَلواتٌ سُندُسٌ طـورُ
كَـذا قَراطيـسُ رَبّانِيِّهِـم وَغَـسـا *** قٌ ثُمَّ دينارُ وَالقِسطاسُ مَشهورُ
كَــذاكَ قَـسـوَرَةٌ وَالـيَـمُّ نـاشِـئَـةٌ *** وَيُؤتِ كِفلَينِ مَذكُورٌ وَمَسطـورُ
لَــهُ مَقالـيـدُ فِــردَوسٌ يُـعَـدُّ كَــذا *** فيما حَكى اِبنُ دُرَيـدٍ مِنـهُ تَنّـورُ
الماءُ مَع وَزَرٍ *** ثُـــمَّ الـرَقـيـمُ مَـنــاصٌ وَالـسَـنـا الــنــورُ
ذكر السيوطي في بداية كتابه اختلاف الأئمة في هذه المسألة، فالأكثرون ـ وهم من أبرز أعلام الأمة ـ، ومنهم الإمام الشافعي، وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوع المعرّب فيه، واحتجوا بقوله تعالى: (قُرآناً عَرَبياً)، وقوله: (وَلَو جَعَلناهُ قُرآناً أَعجَمياً لّقالوا لَولا فُصِّلَت آَياتُه ءاَعجَميُّ وَعَرَبيُّ).
وقال أبو عبيدة: (إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية، فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذاباً بالنبطية فقد أكبر القول).
وذهب آخرون إلى وقوع المعرّب في القرآن، وأجابوا عن قوله تعالى: (قُرآناً عَرَبياً) بأن الكلمات اليسيرة غير العربية، لا تخرجه عن كونه عربياً، فالقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية، وعن قوله: (ءآعجَميٌّ وَعَرَبيٌّ) بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي، واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم للعلمية والعجمة.
وكان اختيار الإمام السيوطي أن القرآن الكريم كان فيه من كل اللغات، وهذا أدلّ على إحاطته بكل شيء، وحكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، واستدل بقوله تعالى: (وَما أَرسَلنا مِن رَّسولٍ إِلّا بِلِسانِ قَومِهِ)، فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو.وذهب قوم مذهباً جمع بين قول من قال إن في القرآن كلمات أعجمية، والقول الآخر الذي ينفي، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام، حيث قال: (والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية، كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال: إنها عجيبة فصادق). (انتهى)
أقول: والدليل على أن العرب عرّبت هذه الكلمات أنك تجد لها أصولاً في المعجمات العربية، فمثلاً كلمة (ناشئة) تجدها في القاموس المحيط، قال:
(نشأ): كمنع وكرُم، نشْئاً ونشوءاً ونَشَاءً ونَشْأة ونَشاءةً: حَيِيَ، وربَا وشبَّ، .... والناشيء ... ج: نشْء، ويُحرّك، وكلُّ ما حدث بالليل وبدأ، ج: ناشئة، أو هي مصدر على فاعلة، أو أول النهار ،أو الليل، أو أول ساعات الليل، أو كل ساعة قامها قائم الليل، أو القَومة بعد النومة...
- الكلام الأعجمي:
جاء فى سورة الشعراء نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين) (1). وجاء في سورة الزمر قرآنا عربياً غير ذي عوج ) (2). وجاء في سورة الدخان: (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) (3). وجاء في سورة النحل: (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين)
ونحن نسأل: " كيف يكون القرآن عربيًّا مبينًا ، وبه كلمات أعجمية كثيرة ، من فارسية ، وآشورية ، وسريانية ، وعبرية ، ويونانية ، ومصرية ، وحبشية ، وغيرها ؟ ".
هذا نص الشبهة الواردة في هذا الصدد ، وتأكيدا لهذه الشبهة ذكروا الكلمات الأعجمية بحسب زعمهم التي وردت في القرآن الكريم وهي:
آدم، أباريق، إبراهيم، أرائك، استبرق، إنجيل، تابوت، توراة، جهنم، حبر حور، زكاة، زنجبيل، سبت، سجيل، سرادق، سكينة، سورة، صراط طاغوت، عدن، فرعون، فردوس، ماعون،مشكاة ،مقاليد، ماروت، هاروت الله.
الردّ على الشبهة:
هذه هي شبهتهم الواهية ، التي بنوا عليها دعوى ضخمة ، ولكنها جوفاء ، وهى نفي أن يكون القرآن عربيًّا مثلهم كمثل الذي يهم أن يعبر أحد المحيطات على قارب من بوص ، لا يلبث أن تتقاذفه الأمواج ، فإذا هو غارق لا محالة.ولن نطيل الوقوف أمام هذه الشبهة ، لأنها منهارة من أساسها بآفة الوهن الذى بنيت عليه. ونكتفى فى الرد عليها بالآتى:
- إن وجود مفردات غير عربية الأصل فى القرآن أمر أقر به علماء المسلمين قديماً وحديثاً. ومن أنكره منهم مثل الإمام الشافعي كان لإنكاره وجه مقبول سنذكره فيما يأتي إن شاء الله.
- ونحن من اليسير علينا أن نذكر كلمات أخرى وردت فى القرآن غير عربية الأصل ، مثل: مِنْسَأَة بمعنى عصى فى سورة " سبأ " ومثل " اليم " بمعنى النهر فى سورة " القصص " وغيرها.
- إن كل ما فى القرآن من كلمات غير عربية الأصل إنما هى كلمات مفردات ، أسماء أعلام مثل: " إبراهيم ، يعقوب ، إسحاق ، فرعون " ، وهذه أعلام أشخاص ، أو صفات ، مثل:" طاغوت ، حبر" ، إذا سلمنا أن كلمة " طاغوت " أعجمية.
- إن القرآن يخلو تمامًا من تراكيب غير عربية ، فليس فيه جملة واحدة اسمية ، أو فعلية من غير اللغة العربية.
- إن وجود مفردات أجنبية في أي لغة سواء كانت اللغة العربية أم غير العربية لا يخرج تلك اللغة عن أصالتها ، ومن المعروف أن الأسماء لا تترجم إلى اللغة التي تستعملها حتى الآن. فالمتحدث بالإنجليزية إذا احتاج إلى ذكر اسم من لغة غير لغته ، يذكره برسمه ونطقه في لغته الأصلية ومن هذا ما نسمعه الآن في نشرات الأخبار باللغات الأجنبية في التلفزة وغيرها ، فإنها تنطق الأسماء العربية نُطقاً عربيّا . ولا يقال: إن نشرة الأخبار ليست باللغة الفرنسية أو الإنجليزية مثلاً ، لأن بعض المفردات فيها نطقت بلغة أخرى.والمؤلفات العلمية والأدبية الحديثة التي تكتب باللغة العربية، ويكثر فيها مؤلفوها من ذكر الأسماء الأجنبية والمصادر التي نقلوا عنها ، ويرسمونها بالأحرف الأجنبية والنطق الأجنبي لا يقال: إنها مكتوبة بغير اللغة العربية ؛ فقط لأن بعض الكلمات الأجنبية وردت فيها ، والعكس صحيح.
ومثيرو هذه الشبهة يعرفون ذلك كما يعرفون أنفسهم فكان حرياًّ بهم ألا يتمادوا في هذه اللغو الساقط إما احتراماً لأنفسهم ، وإما خجلاً من ذكر ما يثير الضحك منهم.
- إنهم مسرفون في نسبة بعض هذه المفردات التي ذكروها وعزوها إلى غير العربية:
فالزكاة والسكينة ، وآدم والحور ، والسبت والسورة ، ومقاليد ، وعدن والله ، كل هذه مفردات عربية أصيلة لها جذور لُغوية عريقة في اللغة العربية. وقد ورد في المعاجم العربية ، وكتب فقه اللغة وغيرها تأصيل هذه الكلمات عربيّا فمثلاً:
الزكاة من زكا يزكو فهو زاكٍ. وأصل هذه المادة هي الطهر والنماء.
وكذلك السكينة ، بمعنى الثبات والقرار ، ضد الاضطراب لها جذر لغوى عميق في اللغة العربية. يقال: سكن بمعنى أقام ، ويتفرع عنه: يسكن ، ساكن ، مسكن ، أسكن.
- إن هذه المفردات غير العربية التي وردت في القرآن الكريم ، وإن لم تكن عربية في أصل الوضع اللغوي فهي عربية باستعمال العرب لها قبل عصر نزول القرآن وفيه.. وكانت سائغة ومستعملة بكثرة في اللسان العربي قبيل نزول القرآن وبهذا الاستعمال فارقت أصلها غير العربي، وعُدَّتْ عربية نطقاً واستعمالاً وخطاًّ.
إذاً فورودها في القرآن مع قلتها وندرتها إذا ما قيست بعدد كلمات القرآن لا يخرج القرآن عن كونه " بلسان عربي مبين "
ومن أكذب الادعاءات أن يقال: إن لفظ الجلالة " الله " عبري أو سرياني وإن القرآن أخذه عن هاتين اللغتين. إذ ليس لهذا اللفظ الجليل " الله " وجود فى غير العربية: فالعبرية مثلاً تطلق على " الله " عدة إطلاقات، مثل أيل ، ألوهيم ، وأدوناي ، ويهوا أو يهوفا. فأين هذه الألفاظ من كلمة " الله " في اللغة العربية وفي اللغة اليونانية التي ترجمت منها الأناجيل إلى اللغة العربية حيث نجد الله فيها " ألوى " وقد وردت في بعض الأناجيل يذكرها عيسى عليه السلام مستغيثاً بربه هكذا " إلوى إلوى " وترجمتها إلهي إلهىي
إن نفى عروبة القرآن بناء على هذه الشبهة الواهية أشبه ما يكون بمشهد خرافي في أدب اللامعقول.
الكلمات التي وردت في القرآن دخلت العربية قبل نزول القرآن وصارت عربية في التعبير، العرب استعملوها. ولا شك في أنه ليس كل شيء موجود في الجزيرة العربية، هل كل النباتات موجودة في الجزيرة العربية؟ كل الفواكه؟ كل الألبسة؟ قطعاً لا. وقطعاً لمّا يصير اتصال في التجارة تدخل مفردات وكلمات وتقارب اللغات يعني تقترب لغة من لغة هذه ليس عندها مثل هذه فتستعمل الكلمات وتدخل لغتها. إذا كان هناك حروف ليست من حروفها تحاول أن تجعل لها حروفاً من حروف اللغة وتدخلها في كلماتها. الكلمات التي في أصولها غير عربية دخلت العربية واستعملها العرب قبل الإسلام بزمن طويل ودخلت في لغاتهم وأعربوها وخضعت للقواعد وأصبحت عربية في الاستعمال ولا نعلم أصولها وقد تكون أصولها غير عربية لكنها الآن أصبحت عربية، قد تكون غير عربية وليست موجودة في الجزيرة العربية مثل سندس واستبرق، العرب لم يكن عندهم مصانع ليستخدموا سندس واستبرق وليس عندهم جميع الأطعمة والفواكه. جميع الكلمات في القرآن عربية الاستعمال قطعاً، القرآن لم يأت بكلمة أعجمية ابتداءً وأدخلها في القرآن. لو أردنا أن نرجع للكلمات الدخيلة الذي يذكرها أهل علوم القرآن نجدها كثيرة لكنها كلها دخلت قبل الإسلام والعرب فهمت هذه الكلمات وكانت تستخدمها في لغتها وفي حياتها فأصبحت عربية الاستعمال. الكلمات الأعجمية أوزانها ليست كأوزان العرب أو تجتمع فيها حروف الدال والزاي مثلاً يضعون لها ضوابط للكلمات غير العربية الأصيلة مثلاً كلمة (مهندز) لا تجتمع الدال والزاي، يضعون بعض الضوابط: اجتماع حروف ليس من طبيعة اللغة أن تجتمع في كلامهم فيقولون ليست عربية أو أوزانها. جميع الكلمات الواردة في القرآن الكريم دخلت في لسان العرب قبل الإسلام ودخلت في كلامهم وأعربوها وأصبحت عربية في الاستعمال.
فشبهتم واهية، لا حجة لهم فيها، إلا إثارة الشكوك في قلوب ضعيفي الإيمان...!.
أفصحنا(صلّى الله عليه وسلّم)
لغة السلام في الحديث الشريف
فالسلامُ اسم من أسماء الله، وما صدر عنه إلاَّ وفيه الأمن والسلام، فلا يكون بعْثُه - تعالى - الأنبياءَ والرُّسُلَ بدعوة دين الإسلام إلاَّ لإقامة الأمن والسلام، وأكمل الإسلام بيد محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - نبيِّ الأمن والسلام، فأقام الأمن والسلام بتبليغ الإسلام إلى البشر كافَّة، وحصل الأمن العالمي والسلام الأخروي، كيف لا، و"الإسلام" (بمعنى السلام) اسمُ دينه، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الحج: 78]، ورحمة للعالمين لقبُه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]، وإقامةُ الأمن غرضُه، وغايته إدخال الناس إلى دار السلام في الآخرة.وإنَّما الأمنُ احتيج إليه عندما غشيت الدنيا سحابُ الخوف والاضطراب من كلِّ الجوانب، وهذا هو تصوير الأيام الجاهليَّة بعينها في سنة ٥٧٠م، كما صوَّرها الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: 164] [الجمعة: 2]، فكان العالم في تلك الفترة غريقًا في ظلام الوثنيَّة، والجهالة، والخُرافات، والبربريَّة، والقتل والقتال والإرهاب والانتهاب، وفي تلك البرهة المظلمة بُعث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمشاعل الأمن والسلام، فخبت نارُ كلِّ ظلم وبربريَّةٍ في اللحظة نفسها، وضاءَ العالَمُ كلُّه بِنُوره وضوئِه.فالآثارُ تُخبر بالأمن والسلام منذ ولادته، وشهد التاريخُ بشعره بالعدل والمساواة في حجر أمِّه، الذي بمنزلة الأصل لإقامة الأمن والسلام، وإنه أسْهَم في إقامة الأمن والسلام في المجتمع حين بلغ أشُدَّه، ورفض بكلمة الأمن النِّزاعَ المفضي إلى نارِ حربٍ عظيمة قُبَيْلَ البعثة حين تنازعوا في الحجر الأسود، ثُمَّ قام بالأمن والسلام بعدها بتعاليمه النبويَّة، وأعماله المحكمة بعد أن كوَّن من أفراد المجتمع إنسانًا حقيقيًّا، فهو أساسٌ لعمل التجديد، وهديهم إلى الأمن بتدابيره العبقرية وببرامجه السياسيَّة، فلإسهاماته في قسم الأمن مزايا في تاريخ العالمَ، ويَجدر ذكرُها الفَيْنَةَ، ففي هذه المقالة أبيِّن - إن شاء الله - دَوْرَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في إقامة الأمن والسلام.
فقسَّمت إسهاماته في عدة مراحل:
(١) إقامة الأمن والسلام بتعاليمه النبوية..
(٢) وبأعماله المحكمة قبل البعثة...
(٣) وبعد البعثة...
ألقي أوَّلاً ضوءًا على الموضوع:
فمعنى الأمن في اللغة: هو ضدُّ الخوف ونقيضه، والأصلُ أن يُسْتَعْمَلَ في سُكُون القلب، وفي الاصطلاح: الأمن عدم توقُّع مكروه في الزمان الآتي...
أما المعاصرون فقد فصَّلوا في معنى الأمن، ومن تلك المعاني: أنَّ الأمن هو شعور المجتمع وأفراده بالطُّمأنينة، والعيش بحياة طيبة، من خلال إجراءات كافية يمكن أن تزال عنهم الأخطار، أيًّا كان شكلها وحجمها، حال ظهورها، ومن خلال اتِّخاذ تدابير واقية.
ومعنى السلام لغةً: المسالمة، والمصالحة، والمهادنة،، وقال أبو عمر: والسَّلْم بالفتح الصُّلْحُ، والسِّلْمُ بالكسر الإسلام ..واصطلاحًا: السلامُ تجرُّدُ النفْسِ عن المحنة في الدارين.
أهمية الأمن والسلام:
للأمن أهميةٌ عُظْمى في حياة الفرد والمجتمع والأمَّة، فهو المرتكز والأساس لكلِّ عوامل البناء والتنمية، وتحقيق النهضة الشَّاملة في جميع المجالات، ولهذا ذكره الله - تعالى - إلى جانب الغذاء، فقال ممتنًّا على أهل مكَّة:
﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: 4]، بل قدَّمه على الغذاء، فقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].
وأشار النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى أهمية الأمن بأنَّ المسلم متى ظفر به، فقد ظفر بالدنيا كلِّها، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من أصبح منكم آمنًا في سِربه، معافًى في جسده، عندَهُ قُوتُ يومِه، فكأنَّما حيزت له الدنيا)).
ويُعَدُّ الأمنُ مقصدًا من مقاصد الشريعة، فقد حصر العلماء المقاصد الضرورية في حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وصَرَّح الماوردي بأنَّ صلاح الدنيا وانتظام أمرها بستة أشياء، منها: أمنٌ عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر فيه الهمم، ويَسْكُن فيه البريء، ويأنس به الضعيف، فبانت منه أيضًا أهميَّة الأمن والسلام.
إسهامُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في إقامة الأمن والسلام:
إقامة الأمن والسلام بتعاليمه النبويَّة وإرشاداته القيِّمة:
إن لُوحظت عدةُ أشياء في مجالات الحياة الدنيوية، فلا شك أن يحصل الأمن العالمي والأخروي هنا، فالنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عرفها، واهْتمَّ بها اهتمامًا بالغًا بِعَمَله، وعَلَّمهَا الناسَ كافَّةً، وهي فيما يأتي:
1- التعلُّق بالله سبب مركزي للأمن في الدارين، وهو أن توحِّد اللهَ ولا تُشرك به شيئًا، فإذا قام الأمنُ من الله - لأنَّ بين الأمن والإيمان علاقةً قويةً - فإنَّ المجتمع إذا آمن أمن، وإذا أمن نَما؛ فيعيشُ أفرادُه مع الأمن حياةً طيبةً؛ قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82]، وقال في موضع آخر: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: 28].
2- الأمن في حسن التعامل مع الناس، وهو أن تُطعمَ الجائع، وتَسقي العاطشَ، وتکسو العُراةَ، وبه يحصل رضا الرب، فتعيش في الأمن والسلام؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدکم حتى يُحب لأخيه - أو قال: لجاره - ما يحب لنفسه)) ، وألاَّ تُسيء إلى أحد بلسانك وبيدك؛ حيث قال: ((المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده)).
3- الأمنُ بين المسلمين وغيرهم؛ لهذا الغرض أمر الله نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - بدعوة غير المسلمين إلى الموافقة على النِّظام في قوله - تعالى -:
﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: 64]، فإذا أعرضوا عنه أمر بالعمل بقوله - تعالى -: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: 6]، وسدَّ بابَ الخوف والفتنة والهيبة كُلِّيةً بقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: 108].
4- السلام بين المسلمين: تلا لإقامة السلام بين المؤمنين قوله - تعالى -:
﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدُکم حتى يُحِبَّ لأخيه - أو قال: لجاره - ما يحب لنفسه)).
5- الأمن بين ذوي الأرحام، فعيَّن له طرقًا متعددةً، وبَيَّن الحقوق مفصِّلاً، وأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه.
6- وإضافة إلى ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لغرض إقامة الأمن بين الحيوانات: ((الخلقُ عيالُ الله، فأحب الخلق إليه من أحسن إلى عياله))
إنَّه نظر إلى هذه الأشياء وغيرها لإقامة الأمن والسلام في الدَّارين، وعلَّمها أصحابَه، وبلَّغها إلى أمَّته جميعًا.
حتى إنَّه - صلى الله عليه وسلم - حمل الأسلحة بيديه لإقامة الأمن الأبدي، واضطر إلى قتالهم کإجراء العملية في الجراح، وإلاَّ لفَسَدُوا في الأرض، کما قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ [البقرة: 251].
إقامة الأمن والسلام بأعماله المحكمة:
شرعت هذه السلسلة منذ أن تحمله أمُّه في رحمها، وتنتهي إلى أن تقوم القيامة، كما نصوِّرها في أن:
1-محمدا مخبر الأمن والسلام منذ ولادته: منذ ولادته ظهرت آثارٌ تُنبئ بأنَّه سيکون صاحبَ الکمال...منها الواقعة الآتية التي تدُل على أنه سيقيم الأمن والسلام على مستوى العالم، وهي أن آمنة لم تحس شيئًا من الثقل والوحم کسائر النساء حين حملته في رحمها؛ تقول آمنة: "ما شعرت بأني حملتُ به، ولا وجدتُ له ثقلاً، ولا وحمًا کما تجد النساء".
2- مثال العدل في الرضاعة: العدل لا بُدَّ منه؛ إذ إنه ضروري لإقامة الأمن، وقد وجدنا فيه هذه الصفة في حجر أمِّه من الرضاعة، بأنَّه كان يشرب اللبن من الثدي اليماني، وكان اليسار لأخيه الرضاعي، فذات مرَّة عرضت له حليمة ثديًا كان يشرب منه أخوه الرضاعي، فامتنع أن يشرب منه.
فوجَّهه بعضُ العلماء: أنه ما كان لمن يقيم الأمن العالمي أن يضيِّع حقَّ أخيه بشرب اللبن فقط، كما ذكر في حاشية ابن هشام أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان لا يُقبل إلاّ على ثديٍ واحدٍ، وكانت تعرض عليه الثدي الآخر، فيأباه كأنه قد شعر - عليه الصَّلاة والسَّلام - أنَّ معه شريكًا في لبنها، وكان مفطورًا على العدل، مجبولاً على المشاركة والفضل.
ودوره - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعد البلوغ فيما يأتي:
إنَّه التزم ببرامج موافقة للحال والمقام لإقامة الأمن والسلام على مستوى الأرض، فنذکرها في الذيل مفصّلاً:
1- المشاركة في تأسيس "حلف الفضول": إنَّه کان حزينًا ومفكرًا في أنه کيف تُحْفَظ الإنسانية من هذا الخوف والاضطراب الدائم، وفي هذه البُرهة حدثت "واقعة الفضول"، فأحسَّ زعماؤهم بصلح بال المجتمع، وأقاموا لجنةً يُصْلَح بها بالُ المجتمع، ويحصل الأمنُ في كل مكان حتى الطريق، وتحفظ بها دماء المسافرين وأموالهم، وتسمَّى بـ"حلف الفضول"، وكان رسولنا الأمين قد أسهم في وضع أساسها، كما قال بنفسه - صلى الله عليه وسلم - عنه: ((لقد شهدتُ في دار عبدالله بن جدعان حلفًا ما أحب أنَّ لي به حمر النعم ولو أُدْعَى به في الإسلام لأجبتُ)).
واتَّفق أركانُ الحلف على البنود التالية:
1- نجهد لإبعاد الاضطراب من المجتمع بقدر القوة.
2- نتأكد بحفظ دماء المسافرين وأموالهم.
3-لا نألو جهدًا في نصرة اليتامى والضعفاء.
4- نقيم علاقةَ الصداقة بين القبائل.
5- نحفظ الناس من الظلم والظالمين.
وغيرها من الفقرات التي تأكدت بحفظ حقوق أفراد المجتمع، كما قيل عن أهداف هذا الخلف:
6-إنّه للدفاع عن المظلومين.
7- رفض كلّ صُور الظلم.
8- منع أكل الحقوق بالباطل.
9- كما أنه حكم عدل في فضِّ النِّزاعات والمشكلات التي تحدث بين القبائل والعائلات، وهو الذي ما أُسِّس إلا لنصرة المظلوم، ونشر العدل بين الناس.
وفي عصرنا يعاهد أرکان لجنة knighthood order (فارس النظام) على مثل هذه البنود التي أسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضع أساسها لقيام الأمن والسلام قبل ألف وأربعمائة عام...
10- الصدُّ عن الحرب الناشئة بکلمة الأمن:
- العرب قوم كانوا يحاربون لأمر تافهٍ؛ كسقي الغنم، وسباق الخيل مثلاً، فوقعت حادثة من أمثال هذه الحوادث حين بلغ - صلى الله عليه وسلم - خمسةً وثلاثين عامًا من عُمره، والتفصيل بأنَّهم أرادوا تجديدَ بناء الکعبة، فاخْتلفوا في تنصيبِ الحجر الأسود وإن شاركوا في البناء على السواء، أخيرًا قضى مربِّيهم (أبو أمية بن المغيرة المخزومي) بعد أربعة أيام بأن يَحْكم بيننا رجل يدخل غدًا بباب المسجد أوَّلاً، ويكون حُکمُه حُکمُ الإطاعة والقبول، فاتَّفق الجميع على هذه المشاورة الثمينة، فرأوا اليوم الثاني محمَّدًا نبيَّنا الأمين سبق إلى الدخول من ذلك الباب، وهم يقولون بأعلى صوتهم: هذا الأمين رضيناه، فما حَکَمَ النبيُّ في ذلك الحين مثالٌ نادرٌ في إقامة الأمن والسلام.وبيانُه ما رُوِيَ بأنَّه - صلى الله عليه وسلم - طلب رداءً، فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حكيم من رجل حكيم تراضت قريش بحكمه.ولقد راح المفكرون والعلماء يعلقون على هذا الحادث بتعليقات مليئة بالتقدير والإعجاب لهذه الشُّعلة العبقرية، التي تحاول في حرص شديد دائم تَحقيقَ الأمن والسلم بين الناس، ومن نجاح محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - تفهُّمُ الموقفِ بسرعة عظيمة، والتوسُّل بهذه الحيلة البريئة، وإرضاء زعماء قريش جميعًا.
هذا كلُّه قبل البعثة، وبعدها توسَّعت هذه السلسلة المذكورة في السطور الآتية؛ لأنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - رتَّبها بعدها مجتمعين؛ لذا أظن أن نبيِّن حقيقةً وسَّع بها الأمن والسلام.
تكوين أفراد المجتمع حقيقة إقامة الأمن والسلام:
من المعلوم أنَّه لا يُمکن أن يرى المرءُ وجهَ الفلاح لعمل التجديد في الدُّنيا لو سعى فردًا، بل ينبغي له أن يَجتهد ويسعى مجتمعًا، هذه الضابطة جاريةٌ ومقبولةٌ عند الناس، فمن فرَّقوا بين الإفراد والاجتماع وقعوا في الخداع، ولو كانوا أولي بأسٍ شديدٍ، والحقيقة أنه لا يتصور أحدٌ من دون الآخر، وتظهر قوة الأفراد إذا كانوا مجتمعين، مع أنه لا ينكر أيضًا أن القوم السخفاء عديمي القيمة لا يفلحون أبدًا، فبقي الكلام على أنَّ بناءَ المجتمع موقوفٌ على بناء الأفراد، والنبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فَهِم هذه الحقيقة، فنظر إلى أفراد المجتمع قبل أن يُلقي يده في ظرف المجتمع.
البرنامج الأصلي خلال هذا العمل:
فجَدَّ وبَذَلَ جُهدَه أوَّلاً في تكوين أفراد المجتمع إنسانًا حقيقيًّا الذي توقف عليه إقامة المجتمع الإنساني المثالي، وإن ننظر إلى بنوده وفقراته التي جَدَّد بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المجتمع، فنجد ثُلُثَه برامجَ أساسية، وهي: 1- التوحيد 2- الرسالة 3- الإيمان بالرُّجوع إلى الله والمسؤولية عن هذه الدار الفانية، فتقدم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بهؤلاء الناس المذکورين، وبلغ أقصى المنازل في عشر سنوات فحسب، حتى لم يُسمع بمثله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في التاريخ، ولم تقع عليه عَيْنُ السماء، ولم تطلع عليه الشمس، فلا يَجيء أحدٌ بمثله في مجالات الحياة كلِّها، لا سِيَّما في إقامة الأمن العالمي، فمن إسهاماته بعد البعثة:
1- ميثاقُ المدينة خطوة أخرى لإقامة الأمن والسلام، ما أخذ لإقامة الأمن والسلام على مستوى الأرض ميثاقُ المدينة الذي يَجدُر ذكرُه، فمن بعض المواثيق :
كانت تعيش أفراد مختلفة نَسَبًا ومِلَّةً ومذهبًا، وکان قوم اليهود أقوى بالنظر إلى غيرهم، وهم يعيشون في الحصن منفردين، فأَخْذُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - الميثاقَ منهم ومن الأقوام المختلفة في المدينة - يَشهدُ بذکائه - صلى الله عليه وسلم - لکي يحصل الاتفاق الجنسي، ولو کانوا مختلفي الأديان والنَّسَب، يُسمَّى هذا بـ"ميثاق المدينة"، ويعرف في العالم بـ"charter of madina"، وكان فيه سبعة وأربعون أو اثنان وخمسون بندًا، منها:
1- الاجتماع على خلافِ الظلم والظالم، 2- النصر للضعفاء، 3- القتل والقتال حرام کحرمة الزنا، 4- النُّصرة للمظلومين، 5- التزام كلِّ سكَّان المدينة من المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما بينهما، وعدم اعتداء أيِّ فريق منهما على الآخر، 6- الدفاع المشترك عن المدينة ضدَّ أيِّ اعتداء خارجي على المدينة، 7- وإنَّ بينهم النَّصْر على مَن حارب أهلَ هذه الصَّحيفة، 8- وإنه لا تُجَار قريش ولا مَن نَصَرها.
وغيرها من البنود التي تقيم الأمن والسلام فقط في المجتمع، وثمة نص واضح وصريح في الوثيقة يتعلق بالأمن، كان بين بنودها العامة: "من خرج آمِن، ومن قعد بالمدينة آمن، إلا من ظلم وأثم، وأن الله جارٌ لمن برَّ واتقى، ومحمد رسول الله".
وبتفعيل هذه الشُّروط في العهد النبوي، تَحَقَّق الأمنُ لجميع المسلمين وغير المسلمين، في خروجهم وبقائهم من غير ظلم ولا إثم.
ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة.
2- سحر مصالحة الحديبية في إقامة الأمن والسلام:
وإنَّما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتل وجاهد بالسيف لإقامة الأمن والسلام وإقلاع الظُّلم من المجتمع، ودلَّ عليه عمله - صلى الله عليه وسلم - بأنَّه مهما عرضت له معركة، ينتطر لمصالحة، فإن يأتوا بالصُّلح يقدّمه على المعركة بهم، وإلاَّ اضْطُرَّ إلى الجهاد، مصالحة الحديبية نظيره اللامع، التي تسمى غزوة الأمن.وکان فيه بنود تخالف مصالِحَ المسلمين، لکن قبلها - صلى الله عليه وسلم - بغرض الأمن فقط؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن في الأمن فتحًا؛ لذا سمَّى الله - تعالى - هذه المصالحة الأمنيَّة بـ "فتح مبين"؛ قال - جلَّ وعلا -: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح: 1].
3- حامل لواء الأمن في فتح مكَّة:
حصل الفتح الأصلي بفتح مكَّة، وغلب الحقُّ والأمن وهُزِم الباطل والخوف، ففي ذلك اليوم لم يبادلهم ظلمًا بظلم، ولا إرهابًا بإرهاب، بل أحسن إلى الأعداء، وعفا عنهم، واسْتَغْفَر لهم من قصورهم وتعدِّياتهم، فأمر جنوده قبل أن يدخلوا مكّة بـ:
1- ألاَّ تقتلوا من ألقى أسلحته، 2- ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، 3- ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، 4- ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، 5- ولا تتعرضوا إلى من أراد الفرار؛ لذا منحه الله - تعالى - هذا الفتح العظيم بلا قتل وقتال، بل في حالة الأمن.وذلك اليوم کان الناس خائفين حين تمّ النصر والفتح، عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم، فأعلن العفو العام، وذکَّرهم بأنه بعث لإقامة الأمن بالعفو والصفح، فقال الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما تظنون أنِّي فاعل بكم؟))، فقالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((اذهبوا فأنتم الطلقاء))[23]، وأعاد قول يوسف - عليه السَّلام -: ((لا تثريب عليکم اليوم))[24].
فعلى الإجمال: إنَّ هذا الفتح فتح لأهل مكة بابَ الأمان واسعًا، ومِنْ هذا الباب دخل الناس في دين الله أفواجًا.
قال المؤرِّخ غيبن عن فتح مكة:
in the long long history of the world there is no instance of magnanimity and forgiveness which can approach those of Muhammad (s.) when all his enemies lay at his feet and he forgave them one and all. -
- کلمة الأمن في حجة الوداع، فأعلن نظام قيام الأمن العالمي بعد سنتين من فتح مكة، فقال خطيبًا في حجة الوداع: ((إنَّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألاَ كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإنَّ أولَ دم أضع من دمائنا دمُ ابن ربيعة بن الحارث - وكان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هُذَيْل - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله)).
وذلك اليوم ترك لسائر الناس أمرين للهداية إلى الأمن في الدنيا وإلى دار السلام في الآخرة، وهما القرآن والحديث.
3- محمد في الکتب السماوية وعند الحکماء مقيمٌ للأمن والسلام:
جاء في الإنجيل: سيجيء رسول من الله إلى الناس كافَّة، يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده سبحانه، آنذاك يسجد الناس لربِّهم، فيعيشون في الأمن والسلام...وشهادة بحيرة: إنه قال حين رآه - صلى الله عليه وسلم -: هذا سيِّد العالمين! هذا رسول ربُّ العالمين! هذا يبعثه الله رحمة للعالمين..
قال جان ليك: لا يستطيع أحدٌ أن يبيِّن عنه، كما يحدّث الله عنه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107].
أخيرًا أقول: إنَّ عالَمَ اليوم كلَّه مضطرب لشريحةٍ من الأمن، وهائم لنيل قبضة من السلام، لكن زعماءه عاجزون عن دركه ونيله، فمن الناس من أسَّس أُسُسًا مُحكمةً متنوِّعةً، وأقام لجنةً مختلفةً لإقامة الأمن، حتَّى إنَّ زعماء العالم الثالث التزموا أن يمنحوا الجوائز في قسم الأمن من الأقسام الستَّة الأخرى، لكنَّهم لم يروا وجه الأمن إلى الآن، ولا شكَّ إنْ لم يُعَدِّلوا بَرامِجَ لَجنتهم ولم يُصَحِّحوا نيَّتهم، فإلى القيامة لن ينالوا قليلاً من الأمن، ولن يصلوا إلى إحدى جوانبه مع صرف أموالهم وبذل جهودهم.
نعم، رَسَمَ لهؤلاء الزُّعماء طريقًا إنْ يسلكوا فيه يفوزوا في نتيجتهم ويصلوا إلى منزلهم مع أنهم كافرون؛ لأنه - عزَّ وجلَّ - أطلق في وصفه - صلى الله عليه وسلم - فقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107].والطريق هي أسوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال سبحانه وتعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21].
مستشارك اللغوي( أخطاء وتصويبات)
بعض الأدباء، أو المثقفين، أو المعلمين، ينصّبون أنفسهم قيّمين على اللغة، ويحترفون تخطئة عباد الله، بحقّ حينا وبغير حقّ أحيانا. هؤلاء هم أصحاب « قلْ.. لا تقلْ»، أو قوائم «خطأ...صواب». لو اقتصر عمل هؤلاء «الغيورين» على تصحيح الخطأ فحسب لهان الأمر. إلا أنهم في الغالب يتجاهلون كلّ التطوير والتوليد والابتكار في اللغة المعاصرة، ويخطّئون كلّ ما يخرج عن النحو أو المعجم الكلاسيكيين. كأنما نحن اليوم نكتب بلغة سيبويه ومعجم ابن منظور، وكلّ ما يشذّ عنهما خطأ لا بدّ من تقويمه. الواحد من هؤلاء أشبه ما يكون بالشرطي الذي «يكمن» على مفترق الطرق لتحرير مخالفات السير: ما دامت مهمّته تسجيل المخالفات وتغريم العباد فلا بدّ من تنفيذ المهمّة بصرامة، واختلاق المخالفات أيضا، في بعض الأحيان، إذا لم يجد مخالفات ومخالفين! يطالع بعض الناس قوائم «الأخطاء الشائعة» هذه، فيكتشفون أن «الأخطاء»، في لغة الإذاعة والصحافة، والأدب أيضا، أكثر من الهمّ على القلب، وأنهم كيفما كتبوا ومهما احترسوا، واقعون في الخطأ لا محالة، ولا سلامة إلا في الصمت!
في الآونة الأخيرة قرأت كتابا من هذا النوع. اشتريته قبل سنين ولم أفتحه إلا اليوم. مؤلّف الكتاب هو الأستاذ نسيم نصر،واسم الكتاب أخطاء ألفناها، وقد صدر في بيروت،سنة 1994. الكتاب من 200 صفحة، وموادّه مرتّبة ترتيبا ألفبائيا تمتد~ في الفهرس على 11 صفحة! إلى هذا الحدّ أخطاؤنا التي ألفناها حتى حسبناها صوابا، وتتردّد في كتب وصحف ودوريّات ونسمعها على ألسنة محاضرين وإعلاميين.
هناك طبعا أخطاء كثيرة في تشكيل بعض الألفاظ وفي صياغتها،صوّبها المؤلف مشكورا، لكنّه يخطّئ ألفاظا وصياغات كثيرة أخرى، لأنه، كما أسلفنا، يحتكم إلى القواعد والمعاجم الكلاسيكية فحسب، متجاهلا مئات السنين من التوليدات والتجديدات والابتكارات التي وصلت بلغتنا المعاصرة إلى ما هي عليه اليوم. لا يمكن بالطبع مناقشة كل «التصويبات» التي أوردها المؤلف، ويصعب علينا الأخذ بها أو بالتفسيرات التي رافقتها، لذا فإننا نكتفي هنا بعيّنة منها، دونما تعليق، ثم نناقش الأستاذ في بعض اجتهاداته أيضا:
ص 9 : دعاية – خطأ، الصواب: دعاوة.
ص 24: تأجير – خطأ، الصواب: إيجار.
ص 27 : بحثتُ عنك – خطأ، الصواب : افتقدتك.
ص 31 : حضر الرئيس بنفسه – خطأ، الصواب: حضر الرئيس نفسه.
ص 35 : مبارتان – خطأ، الصواب: مبارتان في الرفع وفي النصب والجر مباراتين...
ص 39 : الحكم العادل ذنّب فلانا أو قضى بتذنيبه – خطأ ، الصواب: الحكم
العادل قضى بتذنيب فلان على فلان، أي باعتدائه عليه .
ص 41 : تشكّلت الوزارة – فيها خطآن، الصواب: تألّفت الوزارة.
ص 47 : تقييم – خطأ، الصواب: تقويم.
ص 57 : تحاشى – خطأ، الصواب: تجنّب.
ص 63 : حضّر – خطأ، الصواب: أعدّ.
ص 64 : حضرات السادة – خطأ، الصواب: حضرة السادة.
ص 66 : أهنّئك بمناسبة كذا – خطأ، الصواب: أهنّئك بكذا.
ص 74 : بدون – خطأ، الصواب: دون.
ص 80 : زوج ( بمعنى اثنين ) – خطأ، الصواب: زوجان ( بمعنى اثنين).
ص 86 : سويّة – خطأ، الصواب: معا.
ص 100: لن أتراجع طالما الحقّ بجانبي- خطأ، الصواب: لن أتراجع ما بقي الحق بجانبي.هذه عيّنة من التصويبات التي يوردها الأستاذ نسيم نصر في كتابه المذكور متجاهلا، كما ذكرنا، كلّ التجديدات في اللغة المعاصرة. يجدر بالذكر أيضا أن الأستاذ لا يذكر مراجعه عادة، وهي كلاسيكية بالطبع، كأنما هو المصدر والمرجع. أخيرا، فالأستاذ، رغم عمله الدؤوب في التصويب ، لم تسلم تفسيراته وتأويلاته من الخطأ أحيانا. نكتفي هنا بإيراد بعض هذه الأخطاء للتمثيل:
ص 61: والمُحرِم صفة تعني المانع نفسه من المحرَّمات. وعلى هذا الأساس نسمّي الشهر الأوّل من السنة الهجرية محرَّمًا . الخطأ هنا في تفسير المحرم طبعا. فالمؤلف ظنّ أن الفعل أحرمَ، ومنه اسم الفاعل محرِم، هو بمعنى حرّم،لأن إحدى دلالات الوزن أفعل هي التعدية، مثل فعلّ. لكن من دلالات هذا الوزن أيضا: الدخول في مكان أو حالة، مثل:أنجد (نجد)، أتهم ( تهامة)، أشتى (شتاء)، أصاف (صيف)،أورق (ورق)... وعليه يكون الفعل أحرم لازما، ومعناه الدخول في الحرم. ولو كلّف المؤلّف نفسه عناء البحث في القاموس لوجد مثلا (المنجد) : أحرم:دخل في الشهر الحرام، دخل في الحرم أو في حرمة لا تُهتك .
ص 84: إذا تناولنا [...] كلمة ستّ ، وبحثنا عن متناولها المعنوي لرأيناها [واللام هذه لا تقع في جواب إذا، وإنما في جواب لو، وهو أحد أخطاء ألفناها أيضا!] تعني معنى لا يبعد عن معنى السيادة، إذ إنه يعني اختصار الجهات الستّ التي يريد الآخذون به إعطاء السيدة عن طريق تملّك الجهات الستّ . بل يورد المؤلف أيضا ثلاثة أبيات للبهاء زهير يورّي فيها (من التورية في البديع) في كلمة ستّ، والأبيات ذاتها لا تدعم ما ذهب إليه، بل تبيّن خطأه بالذات!
واضح طبعا أن الستّ لفظ من اللغة المحكية، تطوّر من سيّدة . فنحن في المحكية لا نقول سَيّدي بل سِيدي (بمعنى جدّي أيضا)، وفي المؤنث: سِيدْتي تتحوّل إلى سِتّي، ومنها سِتّ طبعا، بمعنى سيّدة أو جدّة!
ص 104: أمّا كلمة عائلة، التي رسخت في الاستعمال بمعنى ذوي القربى الحميمة، وغالبا ما تتألّف من الأبوين والأبناء، فهي صيغة اسم الفاعل مؤنّثا. وأغرب ما في خطأ استعمالها أنها تؤدّي،في حقيقة معناها، ضدّ ما حمّلناها من معنى. العائل القائم بعيالة من هم في عهدته يكفيهم معاشهم. و العائلة مؤنّث العائل. فهل من سبيل إلى اعتماد فصاحة الكلمة وأصالتها البلاغية من منابع العربية، حتى نقلا عن ألسنة العامّة، هذه المرّة، فنستعمل عيلة بدلا من عائلة؟
ونردّ على الأستاذ بأسلوبه، فنقول: هل من سبيل إلى اعتماد المراجع لتعرف أن اسم الفاعل تكون دلالته المفعول أحيانا؟ وهل من سبيل إلى النظر في القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، "ووجدك عائلا فأغنى" فهل معنى العائل في الآية الكريمة مَن يعول أم مَن يعال؟!ما جئنا بهذا المقال إلا لتحذير القرّاء، كلّ القرّاء، من قبول كل ما يُكتب لأنه مكتوب حبرا على ورق. خصوصا حين يغالي الغيورون في تقصّيهم أخطاء العباد، فيعمدون أحيانا إلى تخطئة ما ليس خطأ. ليس كل ما يُكتب صحيحا، وليس كلّ تصويب صائبا!
ملحقة: بالإضافة إلى الكتاب أعلاه، قرأت كتابا آخر من تأليف الأستاذ عبد المعطي إسماعيل عبادة، عنوانه: مثابة الكاتب، الخطأ والصواب في اللغة العربية. هذا الكتاب أيضا يتناول الأخطاء الشائعة ، كما يظهر من عنوانه، ويتّبع النهج السابق إلى حدّ بعيد. لكن لا داعي إلى الخوف، فلن أعرض له في هذا السياق بالتفصيل. مع ذلك لا بدّ لي هنا من إيراد بيتين من الشعر صدّر بهما المؤلّف كتابه، ليرى القراء كيف يصلح الأستاذ أخطاء العباد ويخطئ هو في نظم بيتين اثنين، فيورد الضربين فيهما (التفعيلة الأخيرة من كل بيت) من نوعين مختلفين مخالفا بذلك أحكام علم العرَوض!
هذا الكتابُ ذخيرةٌ **** وخريدةٌ ومثابةْ
فابسطْ إلهي نفعَهُ ****** وامنحْ مؤلفَهُ ثوابَهْ
دراسات أدبيّة، وآراء نقدية
الهجاء السياسي (كلمات لاذعة، وتراكيب موجعة)
ديننا الحنيف لايسمح بالنميمة والغيبة، والسخرية بل يحرمهما في محكم التنزيل ؛ يقول الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" سبحان الله العظيم..
هذه آية في قرآننا نزلت علينا نحن المسلمين بكل ماتحمل من تحذير ونهي شديد عن هذه السلوكيات الذميمة أقول لايكاد يصدق وهو يرى مانحن فيه من مخالفة صريحة لهذا النهي الإلهي، فهاهم المسلمون يسخر بعضهم من بعض وينتقص بعضهم بعضاً ، ويستبيحون دماء بعضهم ، الوحوش تعاف لحوم بعضها ، وبنو البشر يأكلون لحوم بعضهم بعضا؛ يقول الشاعر:
وليس الذئب يأكل لحم ذئب **** ويأكل بعضنا بعضاً عيانا
السخرية والتعالي والنظرة المنتقصة ، وكلمات الهمز واللمز والنكت والتعليقات الجارحة كثيرا ما نسمعها تطلق على قبيلة، أوقبائل معينة أو على جنسية من الجنسيات ، فجماعة يسخرون من جماعة أخرى ويطلقون عليهم النكات والتعليقات التي يتهمونهم فيها بالغباء ،وآخرون يعدون أنفسهم أفضل من أهل البلد الفلاني لأنهم أغنى منهم وأولئك فقراء وأولئك يسخرون من هؤلاء بأنهم بدو جهلة غيرمتعلمين، وآخرون ينتقصون أقواماً بسبب أنهم يرون أنهم أفضل منهم حسباً ونسباً وآخرون يسخرون من أناس بسبب ألوانهم وغيرها من المسببات الواهية التي لاتولد إلا الكره والبغض والحقد والحزازات التي تزيد الفرقه وتشق الصف وتورث البغضاء بين المسلمين الذين ينبغي أن يكونوا أمة واحدة على قلب رجل واحد يسعى بذمتهم أدناهم.
ونظراً لأن هذا الأمر خطر، وأن عاقبتهم سيئة فقد حذرنا الرسول الكريم في الحديث الشريف: (يامن آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لاتغتابوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم ‘ فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتّبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته) أخرجه الحافظ .
كان كل شيء يهون على قريش ، إلا تحطيم الفخر بالأنساب ، والاغترار بالآباء والأجداد ، وما كان يخفى عليهم ما في عقائدهم من سخف ، ولم يخف عليهم أن ما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم خير مما هم عليه من عقيدة ، ولكنهم كانوا يدفعونها بكل ما يملكون من قوة لماذا ؟ وما هو السبب ؟ لأن ما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم فيه تحطيم لسيادتهم وفوارقهم واعتزازهم بأنسابهم . فقد كانت جمهرة الحجيج تقف بعرفات وتفيض منها..أما قريش .. فكانت تقف بالمزدلفة ومنها تفيض ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أشراف قريش يقف بعرفات ، ويأمر الله قريشاً فيقول : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) " سورة البقرة ، الآية : 199 "
تحقيقاً للمساواة بين المسلمين . وكان الرجل من أشراف قريش يأنف أن يزوج ابنته أو أخته من الرجل العربي من عامة الناس؛ فجاء محمد صلى الله عليه وسلم – وهو من قريش – فزوج ابنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يا بني بياضة ، أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه ) " رواه أبو داود والحاكم بسند جيد " وكان حجاماً رضي الله تعالى عنه .
وبهذا كله .. يقف الإسلام فريداً بين جميع أنظمة الدنيا، التي عرفها البشر قديماً وحديثاً لدرء جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض ، وإرهاصه لجميع القيم التي يتكالب عليها الناس ، ليرفع لواء ضخماً واحداً ، يتسابق الجميع ليقفوا تحته ، ألا وهو لواء التقوى ؛ الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من إخطبوط العصبية للجنس ، والعصبية للأرض والعصبية القبلية ، بل والعصبية ضد الرق ليقول صلى الله عليه وسلم ( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ، ومن أخصى عبده أخصيناه ) " رواه أحمد والأربعة " وينقذ البشرية من عصبية الرجل ضد المرأة ، في الوقت الذي كانت الجاهلية تئد فيه البنات ، فيقول الله عز وجل :
( وإذا الموءودة سئلت ؛ بأي ذنب قتلت )" سورة التكوير ،
إنه في الوقت الذي جاء الإسلام فيه محارباً للعصبية ، ومبطلاً لها ، لم يترك باباً من أبوابها إلا أغلقه ، ولا نافذةً من نوافذها إلا طمسها ، سوى نافذة واحدة ،نافذة الدفاع عن العقيدة ، وفي هذا الإطار أبدع شعراء الإسلام الأُوَل قصائدهم ، وأطلوا بهجائهم أمثال حسان بن ثابت ومن نسج على منواله من تلك النافذة ؛فقد دافعوا عن معتقدهم في شعرهم دون إقذاع ،لكن في فيما بعد تحولت القصيدة من هجاء أحادي كما كنا نرى في نقائض جرير والفرزدق مثلا ، إلى هجاء جماعي، إلى وصف قبح الواقع، وإلى تعريته، وكشف المسكوت عنه، وفضحه. لا من أجل صنع مفارقة جزئية أو كلية كما قد يتوهم بعض الدارسين، ولكن من أجل التحفيز على النهوض، فسيكولوجيتنا العربية لا تتحرك أو تبادر إلى الفعل عبر الأوامر أو بيان الخصال الحميدة ، والسجايا الطيبة، ولكنها تبادر إلى ذلك الفعل المؤثر بعد كيِّها، أو تعييرها، أو ذمها . ويعد شعر دعبل الخزاعي، وهجائيات المتنبي لكافور صورة مثلى محفزة، على الرغم من أنها هجائيات فردية أحادية، ويجيء بيت دعبل الشهير:
إني لأفتح عيني حين أفتحها
على كثير ولكن لا أرى أحدا
بيتا حادا مسنونا، ضاربا بأعناق الدلالات ، إذ إنه ينفي تماما أن أحدا موجودا أمامه، في فعل تغييب، وفعل سخرية، وفعل مفارقة معا، وهو البيت الذي تناص معه الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي في قصيدة له معبرا بقوله:" هذا الزحام .. لا أحد" .
وكما كانت قصيدة المدح لا تتقدم – في تحليلها الأخير – لوصف الممدوح مباشرة ( خليفة كان أم واليا) حيث كانت تنشد القيم الخلقية العامة، أو تقدم النموذج الذي ينبغي أن يكون عليه الخليفة أو إمام المسلمين ( على حد تأويل الدكتور شوقي ضيف) ، فإن قصيدة الهجاء أيضا لا تهجو بالضرورة الشخص الذي تكتب فيه قصيدة الهجاء، ولكنها تهجو الواقع نشدانا لعالم أفضل،
لقد ورث الشاعر المعاصر هذه الذهنية، لكنه في عصر القومية مارس دوره الهجائي بإتقان، خاصة حين تعرضت هذه القومية لنكبة العام 1948 ثم نكسة العام 1967من هذا المنظور انطلقت الكتابات الشعرية السياسية لدى أبرز شعراء الهجاء السياسي المعاصرين: نزار قباني، مظفر النواب، أحمد مطر، أمل دنقل ،فالهجاء تطور شعريا في العصر الحديث من هجاء فردي أو قبلي كما تمثل في شعريتنا العربية القديمة ، إلى هجاء سياسي شامل، يهجو الواقع السياسي ، فساد العالم، وخرابه، يهجو أقزامه وخصيانه الذين استعبدتهم المادة واستعبدهم العصرما جعل لقصيدة الهجاء السياسي سمات عدة :أولها: أنها قصيدة موجهة للمجموع: الوطن، القادة ، الجماهير. ..يقول مظفر النواب موجها كلامه اللاذع لأمته وبلدانها:
لم يعد يليق بك يا أمة مؤتمراتها مؤامرات
وكلامها تفاهات وقراراتها وهمية
لم يعد يليق بكِ التحيةّ ..
يا أمة بدلت إسلامها بدين الديمقراطية!!
ما أخبار فلسطين ؟! ..
شعب بلا وطن .. وطن بلا هوية
ما أخبار العراق ؟! ..
بلد الموت اللذيذ والرحلة فيه مجانية ..
ما أخبار ليبيا ؟! ..
بلدّ تحولّ إلى معسكر أسلحة وأفكار قبلية
ثانيها: أنها قصيدة تأتي غالبا بعد حدث مأساوي: النكبة والهزيمة العربية مثلا أمام إسرائيل، النكوص والهروب من المواجهة وتكلس الجيوش العربية وتقاعسها كما في غزو إسرائيل للبنان في العام 1982 ، الانكسار العربي الجماعي كما في حرب الخليج الثانية، وتداعياتها حتى غزو جيش الاحتلال الأمريكي العراق وسقوط بغداد الأليم.
يقول نزار بعد الهزيمة:
أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغةَ القديمه والكتبَ القديمه
أنعي لكم.. كلامَنا المثقوبَ، كالأحذيةِ القديمه.. ومفرداتِ العهرِ، والهجاءِ، والشتيمه.. أنعي لكم.. أنعي لكم نهايةَ الفكرِ الذي قادَ إلى الهزيمه ....
ثالثها: أنها قصيدة تعتمد على آليات المفارقة، والسخرية، كما أنها تعتمد على جماليات المباشرة.
يقول أحمد مطر ساخرا:
أكثَرُ الأشياءِ في بَلدَتِنـا الأحـزابُ، والفَقْـرُ، وحالاتُ الطّـلاقِ .
عِنـدَنا عشرَةُ أحـزابٍ ونِصفُ الحِزبِ في كُلِّ زُقــاقِ !
كُلُّهـا يسعـى إلى نبْـذِ الشِّقاقِ ! كُلّها يَنشَقُّ في السّاعـةِ شَقّينِ
يَنشَـقُّ على الشَّقّينِ شَـقَّانِ وَيَنشقّانِ عن شَقّيهِما ..
من أجـلِ تحقيـقِ الوِفـاقِ ! جَمَـراتٌ تَتهـاوى شَـرَراً
والبَـرْدُ بـاقِ ثُمّ لا يبقـى لها إلاّ رمـادُ ا لإ حتِـرا قِ !
لَـمْ يَعُـدْ عنـدي رَفيـقٌ رَغْـمَ أنَّ البلـدَةَ اكتَظّتْ بآلافِ الرّفـاقِ !
ولِـذا شَكّلتُ من نَفسـيَ حِزبـاً ، ثُـمّ إنّـي مِثلَ كلِّ النّاسِ –
أعلَنتُ عن الحِـزْبِ انشِقاقي !
رابعها: أنها تصل الماضي بالحاضر، تتناص مع الموروث كما تتناص مع الواقع الراهن.،ولاتلتزم بأخلاقيات الدين الحنيف، بل تغوص في أعراض المهجوين ويجد الشاعر لهذا الغوص مايبرره..يقول نزار:
شنقوا التاريخ من رجليه باعوا الخيل والكوفية البيضاء
باعوا أنجم الليل وأوراق الشجرْ سرقوا الكحل من العين
وباعوا في عيون البدويات الحورْ.....
خامسها: أنها تعتمد شعرية اللقطة أو الومضة غالبا ، والوصول إلى المعنى من أقصر طريق.
سادسها: تستخدم الترميز والإسقاط الرمزي على الواقع الراهن، من خلال القناع، عبر توظيف الشخصيات التراثية وغيرها من
الآليات. نزار يلجأ إلى الترميز:
يا صلاح الدين..هذا زمن الردة..
والمد الشعوبي القوي ..أحرقوا بيت أبي بكر..
وألقوا القبض في الليل على آل النبي
فشريفات قريش ...صرن يغسلن صحون الأجنبي..
هذه السمات تجدها تتكرر في كثير من شعر نزار وأمل دنقل، و أحمد مطر ، لكن نزار ألقى نفسه في دائرة النار عندما بدأ مبكرا يخرج على المألوف، ويخالف السلوكيات الإيمانية فكفروه حين قال :
(من أين يأتي الشعر يا قرطاجة..والله يعبد.... وعادت الأنصاب)
فقالوا :ادعى بأنَّ الله تعالى لم يعبد وأن الأصنام والأنصاب قد عادت..وتساءلوا: أليس هذا كفرا؟
وكما قالوا:يصف هذا الشاعر (الشعب) بصفات لا تليق إلا بالله تعالى فيقول في ديوانه (لا غالب إلا الحب) صفحة 18:
( أقول : لا غالب إلا الشعب للمرة المليون لا غالب إلا الشعب
فهو الذي يقدر الأقدار وهو العليم، الواحد، القهار)..
لكن نزار أحس فيما بعد أنه تجاوز مانهى الإسلام عنه، فبادرإلى الاعتذار في القصيدة التي نسبت إليه يقول فيها:
أدنو فأذكـــــــر مـــا جنيت .. فأنثني ،،،
خجـلا .. تضيـق بحمــــلـي الأقــــدامُ ...
أمن الحضيض أريد لمسا للـــذرى؟؟ ،،،
جل المقـــــــــــام .. فلا يطـــال مـقامُ ...
وزري يكبلني .. ويخـــرسني الأسى ،،،
فيموت في طرف اللســـان كـــــــلامُ ...
يممت نحوك يا حبيــــب الـلـــه! في ،،،
شـوق .. تقض مضاجـعي الآثــــــامُ ...
أرجو الوصول فليل عمـري غابـــة ،،،
أشـــــــــواكـــــــــها الأوزار .. والآلامُ ...
لافتات أحمد مطرتقرع الحاضر، والمستقبل بكلمات لاذعة لذعا مراً، وتراكيب لغوية قوية موجعة، لكن لها مايبررها أحيانا ،فالواقع المر يجعل الكلمات أكثر مرارة في أفواههم، والأسى يدفعهم إلى تراكيب موجعة واخزة...
وأحمد مطر ليس لديه من التجاوزات ما يعتذر عنه كنزار قباني،لكن هناك شعراء أفقدوا الكلمة حدتها ،والتركيب وقعه؛لأنهم لفساد مبتغاهم ، ورخص غاياتهم المادية التي يعرفها القاصي والداني، وأصبح حال الواحد منهم ينطبق عليه الوصف القديم لأحد المطربين الذي قيل :إنه (لا يغني إلا بدرهم.. ولا يسكت إلا بدينار)! فهؤلاء يخرجهم الجمهور بذائقته من دائرة الشعراء أصحاب الهمم العالية الذي قاتلوا بكلماتهم وأوجعوا بمعانيهم..
اللغة في حياتنا
الدخيل في المفردات والأسلوب
حين كان العرب في أوْجِ حضارتِهم، وحين كانوا يبنون حضارةً جديدة ملكوا الشجاعة الكافية لاستخدام المفردات الدخيلة دون حرج ،أو خوف سواء أكان في لغة الكتابة أم الشعر، أو في حياتهم، وقد اُستخدِمَتِ المفرداتُ الدخيلة لسدّ نقص في المفردات العربيّة فيما يتعلق بأدوات الحضارة، والعمران، والأدوية والعقاقير... إلخ، أي فيما يتعلق بمفاهيم وأدوات دخلت حديثاً في حيّز الاستخدام، وجاءت تحمل معها أسماءَها، فحين يطوّر المجتمع حاجاته، ويخترعها، أو يكتشفها فإنّه يكتشف أسماءها أيضاً، أو يعطيها أسماءَها، ولكن حين يستخدمها بعد زمن استخدام أهلها لها، حين يستعيرها من أمم أخرى؛ فإنّه يستعير أسماءها أيضاً.
ولكنّهم كثيراً ما استخدموا مفردات غير عربيّة دون ضرورة، فلها ما يقابلها في العربيّة، وكان ذلك نتيجة للتعايش والتعامل مع الأمم الأخرى، فقد دخلت مفردات كثيرة في أشعارهم، وأقوالهم ،وأحاديثهم وحكاياتهم (لاستملاحهم) لها، ولشيوعها بين العامّة، واستخدامها استخداما واسعاً.
الدخيل في المفردات
وقد تعاملوا مع المفردات الدخيلة على وجهين رئيسين:
الأوّل: تركوا المفردة كما هي، وأجروا عليها تحريفات، وتعديلات حتّى يمكن النطق بها؛ مثل: نموذج، الأصل "نموده" وتعني نوعاً، أو مثالاً بالفارسيّة...
والثاني: عرّبوا قسماً من هذه المفردات، وأدخلوها في بِـِـنْية الكلام العربيّ، فجاءت على صيغ العربيّة وأوزانها، واشتقّوا منها، أي عاملوها معاملة اللفظ العربيّ، والأمثلة كثيرة منها: أستاذ. إبريق. ديوان، دستور، طابور، كرباج، صاج، قرطاس، فانوس، برج، شاش، دمية، تلميذ.....
أمّا الآن فإنّنا نجد حرجاً شديداً في استخدام المفردات الدخيلة، ويعود ذلك إلى كَثْرة هذه المفردات التي هجمت علينا، وإحساسنا بالعجز تجاه ما تقذفنا به الحضارة من مفاهيم، ومخترعات؛ علماً أنّ العربيّة تملك وسائل كثيرة لزيادة ثروتها اللغويّة، ومنها: الاشتقاق، والتركيب، والنحت.
على كلّ حال ليست العربيّة بدعاً في هذا، فالّلغات تؤثر في بعضها بعضاً، ولا حيلة لنا في الأمر ما دمنا في طور النمو الحضاريّ، وما دمنا عالة، ومستهلكين للحضارة لا أكثر، ولذلك فقد دخلت العربيّةَ كثيرٌ من المفردات الأجنبيّة، وشاعت في الاستعمال ،ولغة الكتابة، ولكنّ بعضهم مازال يعدّ العديد من هذه المفردات أخطاءً شائعة، ويدخلونها في هذا الميدان ، ويضخّمون الأخطاء الشائعة، ويجعلون منها قائمة لا تنتهي، ويتزّيدون تزيّداً كثيراً لا معنى له ولا مسوّغ له من ذلك أنّ عباس أبو السعود في كتابه أزاهير الفصحى يقول: (ويقولون لمن يتصل بالشعب، ويحس بآماله، وآلامه: ديموقراطي والصواب أن ينسب إلى الشعب فيقال:( شعبيّ). وهو في هذا لم يتطرّق إلى المصدر الصناعي (الديموقراطيّة) فهل نقول معتمدين على توجيه (الشعبيّة) بدلًا من الديمقراطيّة؟
والحقيقة أنّ الديمقراطيّة ليست هي الشعبيّة، وإن كان هناك نقاط التقاء بينهما، وبالنتيجة فإنّ (شعبي) لا تقابل (ديموقراطي) إلّا تقريبيّاً، ثم إنّ كلمتي (الديموقراطيّة والديموقراطي) كلمتان شائعتان متداولتان في الكتابة، وفي اللّهجة، وعلى هذا فلا يمكن عدّهما في الأخطاء الشائعة إنّما هما لفظتان دخيلتان تؤديان معنى محدّداً.
ومن ذلك أيضاً ما يقوله المؤلف نفسه :(كما يقولون للمترفع عن الشعب ارستقراطي، والفصيح أن يقال له: سَروي، منسوب إلى السَرِيّ ، وجمعها سَراة ؛وهو المروءة في شرف) ،وعلى هذا فيمكننا القول بدلاً من الأرستقراطية (السَرَويّة) ،ولكنّ المروءة في شرف لا تتطابق في دلالتها مع (الأرستقراطي) ويقول محمد العدناني في هذا أيضاً: (يقولون الأرستقراطيون، والأرستقراطية.. والمقترح لما يقابله المترفون، والإتراف). تصدق على الأرستقراطيين كما تصدق على غيرهم.
وقد شاعت كلمة (النبلاء) مقابل (الأرستقراطيين) وقد يقال أيضاً :طبقة النبلاء.. وهي كلمة مناسبة في هذا الميدان فضلاً عن شيوعها.
ومن ذلك: (السبانخ) للنبات المعروف، وهم يقولون: هذا خطأ شائع، والصواب كما ذكرته المعاجم (السباناخ)، وهي كلمة دخيلة ،لكنّها حُرّفت إلى (سبانخ أو سباناخ)،وإذا كان العرب سابقاً قد لفظوها (سباناخ) فما يمنع أن نلفظها (سبانخ) وهي أسهل في النطق، وهي كلمة دخيلة بكلّ الأحوال، ومن ذلك: (البقدونس) يقولون: هذا خطأ شائع ،والصواب كما ذكرته المعاجم (المقدونس) ، وهو لفظ دخيل ويصدق عليه ما قلناه عن الساباناخ، أو السبانخ :نبات كالسلق، فارسيّة معرّبة كما نلفظها الآن .
وهذه، وكثيرٌ غيرها كما قلنا سابقاً ليست أخطاء شائعة، بل فرضتها ضرورات التطوّر ،والاتصال بالأمم الأخرى، وما علينا إلّا إيجاد المقابل العربيّ المناسب لها.
وهناك الكمّ من المفردات التي شاع فيها اللفظ الأجنبيَّ، وتوارى اللفظُ العربيّ، وهذه بالذات يمكن أنّ تعدّ من الأخطاء الشائعة، من ذلك:
بوفيه، يقابله في العربية المقصف. الشيفرة يقابلها في العربية الجفر، أو الرمز، والبكالوريا تقابلها الثانوية ،والليسانس تقابلها الإجازة، والسينما تقابلها الخيالة، والصالون للردهة، والديكتاتور يقابله المستبدّ أو الطاغي ،والراديو يقابله المذياع ،والتلفزيون أو التلفاز يقابله الرائي ،والتليفون يقابله الهاتف والكاتو يقابله الفرنيّة، والسندويشة ويقابلها الشطيرة.. والحقيقة فإنّ هذه كثيرة كثرة فاحشة، وقد دخلت العربيّة في العصر الحديث ، وشاعت على كلّ شفة ولسان ،وحين شاعت حاولوا استدراكها، ووضعَ مقابل لها، فُوفّقوا أحياناً وأخفقوا أحيانًا أُخرى، فهي بالنتيجة ليست أخطاء شائعة، لأنّها جاءت تلبيةً لحاجات التطوّر ،وضرورات الرقيّ والتمدّن، وقد دخلت في لغتنا؛ لأنّها دخلت في حياتنا كأدوات استعمال ،وآلات، أو ك
الدخيل في الأسلوب
من المناسب أن نتحدّث هنا عن الأساليب الجديدة التي جاءت نتيجة للترجمة الحرفيّة من اللغات الأجنبيّة التي تُعدّ(تشويهات) في اللّغة، أو في الأسلوب العربيّ الأصيل، ولكنّ دراستها بدقّة تكشف أنّها شكل من أشكال تطوّر اللّغة، إذ من المستحيل ألّا تتأثر اللّغة بغيرها، ومن المستحيل أن يظلّ الأسلوب العربيّ هو الأسلوب الذي كتب فيه الأجداد، ومن ذلك قولهم:
-شنّ حرب إبادة ضدّ الشعوب الضعيفة.-ثار (ضد) الحكم، أو ضد الدولة. خاض معركة ضد الإباحيّة، أو قام بمعركة ضدّ الإباحيّة.
-تعصب ضد فلان ، والأسلوب العربي الفصيح يقول:-شنّ حرب إبادة على الشعوب الضعيفة.-ثار على الحكم أو على الدولة.
-خاض معركة مع الإباحيّة، أو قام بمعركة مع الإباحيّة. -تعصّب على فلان.
ومن أساليب التشويه هذه أيضاً قولهم: -يشكّل عنصراً هامّا. -يشكّل تقدّماً عظيماً. -يؤلّف مشكلة..
يقابل ذلك في الأسلوب العربي الأفصح: هو عنصر مهمّ، وفيه تقدّم عظيم، وهي مشكلة.
ومن ذلك أيضاً:
لعب دوراً هامًّا. يقابله: كان له شأن عظيم، أو أدّى دوراً، أو أيّ جملة أخرى تؤدّّي هذا المعنى.
واضح ممّا تقدّم أنّ هذه الأساليب، وإن لم تستخدم سابقاً في العربيّة، فإنّها لا تخرج على اللّغة، ولا تكسر قواعدها وكلّ ما هنالك أنّ الألفاظ في السياقات التي وردت فيها اكتسبت معاني جديدة لم تكن لها من قبل، مثل: (لعب، أو شكّل، أو ألّف...).
وعلى كل حال فإنّ لغة الكتابة لا تهتم بمثل هذه التوجيهات أو الاعتراضات، وتستخدم هذه الأساليب وهذا لا يمنعنا من أن نبحث عن الكيفية التي وصلت فيها هذه الأساليب إلى العربية، وبمعنى أدق، نبحث عن الكيفية التي تطوّرت فيها هذه المفردة أو تلك لتؤدي هذا المعنى الجديد الذي لم يكن لها سابقاً، إنّ هذا المعنى الجديد كما أسلفنا جاء من وضع الكلمة في سياق معيّن من خلال الترجمة.
أمّا كلمة (ضد) التي وردت في كثير من الأمثلة، فإنّها لم تخرج عن معناها، وإذا كان قولنا: (شنّ حرب إبادة على الشعوب الفقيرة) أسلوب فصيح، فقد أُضيف إليه أسلوب آخر يجعل (ضد) بدلاً من (على)، ويمكن أن نستخدم مثل هذا الاستخدام عند أمن اللبس، وقد عدّ بعضهم أنّ أمن اللبس من أنواع، أو أشكال التضمين كقول عنترة:
بَطَلٍ كأنّ ثيابَهُ في سَرحَةٍ ... يُحْذَى نِعالَ السِّبْتِ لَيْسَ بتَوْأَمِ
وُصِف لطوله أنّ ثيابه معلّقة على شجرة طويلة، ومعنى السرحة: الشجرة
المهمّ أنّه لا حدودَ لأساليب اللّغة، وكلّ ما أدّى فيها المعنى، وكان صحيحاً من الناحية الإعرابيّة، فهو صحيح أيضاً من الناحية الأسلوبيّة، ففي اللّغة تتركب أساليب كثيرة جداً فما بالنا نمنع هذا، ونجيز ذلك، فكلها صحيحة مادامت على حدّ اللّغة.؟!
ومن الأساليب التي جاءت نتيجة الترجمة، قولهم: (عناية واهتمام الأم بطفلها) و(أحضرنا كتب وثياب الرجل) أي أضاف إلى مضاف إليه واحد أكثرَ من مضاف، والصواب في هذا أن يقول :(وعناية الأم بابنها واهتمامها به) و (أحضرنا كتب الرجل، وثيابه). ومن ذلك أيضاً قولهم: (وفي حديثه عن كذا، قال الرئيس كذا...) وفي هذا أخّر الفاعلَ وقدّم ضميره عليه، والصواب أن يقال: (والرئيس في حديثه عن كذا قال كذا...). واضح هنا أنّ هذه الأساليب ((المحرّفة)) تخرق القاعدة النحويّة، ولا تراعيها، وهي وإن كانت صحيحة من حيث المعنى، إلّا أنّ صحة المعنى لا تشترط دائماً الصِحّة النحويّة، فقد يكون المعنى صحيحاً، والتركيب خاطئاً.
ومن هذه الأساليب أيضاً قولهم:
-حضر فلان كما حضر علّان، والأفضل حضر فلان وعلّان، فاستخدام (كما) لا أساس له..
-فلان عليه دين ألف فقط لاغير، والأفضل فلان عليه دين ألف فقط...
-المدرسة عبارة عن فصول ومختبرات، والأفضل المدرسة فصول ومختبرات ومكاتب..
-جاء القائد ثم جاء بعده الجنود، والأفضل جاء القائد ثمّ الجنود
-يجب عليك الوقوف احتراماً، والأفضل عليك الوقوف احتراماً
-هذا مجرّد رجل واحد، والأفضل هذا رجل واحد
-سار بصورة جيدة، والأفضل سار سيراً حسناً.
-مشيت بشكلٍ حسن. والأفضل مشيت مشياً جيداً.
-ظهر على نحوٍ واضح. والأفضل ظهر ظهوراً واضحاً
وهنا نلاحظ أنّ هذه الأساليب تنحِّي المفعولَ المطلق جانباً، وتقلّل من استخدامه، وتُنهِض دلالاتها بأسلوب، وإنْ كان يستخدم حدود اللّغة، وقواعد النحو إلّا أنّ فيه التواء، فضلاً عن أنّ الأسلوب العربي أشدّ وضوحاً، وأكثر مرونة، وأكثر بلاغة، ولكنْ لا حقّ لأحد بتخطئة مثل هذه الأساليب.
ومن ذلك قولهم: (فلان بطل بكلّ معنى الكلمة)، والأسلوب العربيّ هو (فلان بطل صنديد، أو بطل عظيم ..إلخ.. إنّ المقصود بقولهم:(بكلّ معنى الكلمة) يراد منه نفي أن تكون كلمة البطولة قد استخدمت استخدامًا مجازيّاً، فالكلمة قد استخدمت استخدامًا حقيقيّاً، وليس مجازيّاً، وهذه في العربيّة هي إحدى الخدمات التي يقدّمها المفعول المطلق لفعله، ولكن هنا يمكننا أن نستخدم أيّ أسلوب ينفي المجازيّة عن الكلمة، وذلك باستخدام الصفة، أو غير ذلك، حتى إنّنا لا نرى ضيراً في استخدام الأسلوب السابق الذي ذمّوه. ومن ذلك أيضاً قولهم: (ذهب إلى بيته الكائن في كذا) والأسلوب العربيّ هو(ذهب إلى بيته في كذا). ومن ذلك أيضاً استخدامهم: بخصوص، فيما يتعلق، وبالنسبة إلى كذا...إلخ. وفي العربية ما يغني عن هذه باستخدامنا لـ(أمّا، ومن حيثُ...).
ومن ذلك قولهم: (نحن كمسرحيين عرب..) والأسلوب العربيّ (نحن المسرحيين العرب ..) ونميل إلى الاعتقاد بأنّ هذا الأسلوب المحرّف، ووضع حرف الجرّ هو نوع من (التحايل) على قواعد اللّغة، إذ يحار المتكلم هل يقول: (نحن المسرحيين العرب)، أم يقول :(نحن المسرحيّون العرب... وللخروج من هذه الحَيْرة، يأتي بأسلوب جديد، ويدخل حرف الجر (الكاف) لتكون دلالته واضحة على الجرّ...
ومن ذلك قولهم :(عامله كحيوان ) والأسلوب العربي (عامله معاملة الحيوان )، ونلاحظ هنا أنّ الأسلوب الجديد يختصر اختصاراً مفيداً، إذ لا يصحّ في الأسلوب العربي أن نقول: (عامله حيواناً).
ومن ذلك قولهم:(فلان يأكل كثيراً، وبالتالي يتخم) والصواب (فلان يأكل كثيراً، ثمّ يتخم)، و((بالتالي)) شبه جملة ركيكة جدّاً، ولا أدري كيف وصلت إلى عدد كبير من كتّابنا.. ويمكن أن نقول أيضاً، ولعلّه الأكثر دقةً: (فلان يأكل كثيراً فيتخم)
إنّ استخدام الفاء هنا أكثر دقّة، وأكثر إصابة، مع هذا فإنّ هذه الأساليب جميعها بما فيها الأسلوب الأوّل تؤدّي المعنى، وتوضّحه، كما أنّها لا تخرج عن حدود اللّغة، ولا يعنينا أنّ (بالتالي) ركيكة مادامت صحيحة، هذا الحكم يهمّنا حين نصدر حكماً على نصّ أدبيّ لا على نصٍّ ((إبلاغي))، أو اتصالي. ومثل هذا قولهم: (الأمر الذي حملنا على نقله إلى المستشفى هو إصابته بالحمّى) والصواب
( ماحملنا على نقله إلى المستشفى..) أو (إصابته بالحمى حملتنا على نقله...)؛ لأنّ استعمال كلمة (الأمر هنا ركيك جداً، وليس عربيَّ الأصول والسبك، وربما دخل الضاد بأقلام ضعفاء المترجمين...
كما نلاحظ هناك كثيراً من الطرائق، والأساليب للتعبير عن ذلك المعنى بعضها جيد، وبعضها أجود، وبعضها أقل جودة، ولكنّ النتيجة واحدة، ويصدق على هذا القول ما قلناه عن القول السابق.
وممّا شاع استعماله في الأساليب أيضاً قولهم:
-ما أحسنه كمتحدث، أو كمتكلم، أو ككاتب، والأفضل ما أحسنه متحدثاً، أو متكلماً، أو كاتباً.
-دخل عليهم كرئيس للبلاد، والأفضل دخل عليهم رئيساً للبلاد.
-عامله كحيوان، والأفضل عاملهُ معاملة الحيوان
-كانت هذه الحرب كنتيجة للاغتيال، والأفضل كانت هذه الحرب نتيجةً للاغتيال...
في هذه الأساليب يغيب التمييز، أو الحال، أو المفعول المطلق، أو المفعول لأجله، ليحلّ محله حرفُ الجر ،والتشبيه ،ولعلّ في هذه الأساليب (تحايلاً) على القواعد النحويّة، إذْ إنّ هذه الأساليب تعفينا من مسألة تحديد هذا الاسم المنصوب؛ هل هو حال أم تمييز أم مفعول لأجله، أم مفعول مطلق...؟ إنّه في هذه الأساليب كلّها اسم مجرور. وهكذا نتخلّص من المشكلة كلّها بالتخلّص من الأسلوب نفسه، وإحلال أسلوب بديل عنه.
وعلى كلّ حال، ومهما كان السبب، فإنّ هذه الأساليب ((المحرّفة)) أو الجديدة تراعي حدود اللّغة، وتحترم علاقات التركيب، وقواعد النحو، ولا تخرج عليها، بل تطبّقها في استخداماتها هذه، بل لعلّها تلجأ إليها من أجل مراعاة قواعد النحو ذاتها.
إنّ مايؤخذ على هذه الأساليب: أنّها لم تُستخدم عند العرب سابقاً، وأنّها تميل أحياناً إلى التطويل، أو الالتواء، مقابل الاختصار والوضوح، والإشراق في الأسلوب العربيّ القديم.
وهذه المآخذ لا تمنعنا في الحقيقة من استخدام هذه الأساليب بعد شيوعها في لغة الكتابة شيوعاً كبيراً، فلماذا لا نستخدم إلّا ما استُخدم سابقاً؟.
إنّ هذه الأساليب نفسها ستغيب تلقائيّاً بعد حين لتحلّ محلها أساليب أخرى جديدة، كما حلّت هي محل أساليب سبقتها، ألا ترى أنّ ثَمّة أساليبَ كثيرة عفا عليها الزمن، وتحوّلت إلى مستحاثات لغوية؟ إذاً لا ثبات لهذه الأساليب مادامت اللّغة تتطوّر وتتغيّر، وتتبدّل وتلك سنّة من سنن الكون، والطبيعة، والحياة، واللّغة...
ولنعترف هنا أنّ بعضهم يتزّيد في هذا، فيضع الخطأ الشخصي موضع الخطأ العام، أو الأسلوب العام، ومن ذلك قولهم (استند ضد الجدار، والشكوى ضد الحياة). إذ واضح أنّ هذه غريبة على السمع، وأنّها إذا وقعت في كتاب مترجم، أو غير مترجم فهي لا تتعدّاه إلى غيره، إنّها خطأ شخصي، خطأ فردي، وليست خطأً عامّاً، ولا شائعاً، ولا تستدعي التوجيه إلّا لصاحبها.
نجوم وكواكب
الكسائيّ... (شيخ مدرسة الكوفة)
الإِمَامُ، شَيْخُ القِرَاءةِ وَالعَرَبِيَّةِ، أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ بَهْمَنَ بنِ فَيْرُوْزٍ الأَسَدِيُّ مَوْلاَهُمْ الكُوْفِيُّ، المُلَقَّبُ: بِالكِسَائِيِّ؛ لِكِسَاءٍ أَحرَمَ فِيْهِ.تَلاَ عَلَى: ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَرْضاً، وَعَلَى حَمْزَةَ.وَحَدَّثَ عَنْ: جَعْفَرٍ الصَّادِقِ، وَالأَعْمَشِ، وَسُلَيْمَانَ بنِ أَرْقَمَ، وَجَمَاعَةٍ.وَتَلاَ أيضا على: عيسى بن عمر المقرئ.وَاخْتَارَ قِرَاءةً اشْتُهِرَتْ، وَصَارَتْ إِحْدَى السَّبْعِ.
وَجَالَسَ فِي النَّحوِ الخَلِيْلَ، وَسَافَرَ فِي بَادِيَةِ الحِجَازِ مُدَّةً لِلْعَرَبِيَّةِ، فَقِيْلَ: قَدِمَ وَقَدْ كَتَبَ بِخَمْسَ عَشْرَةَ قِنِّيْنَةَ حِبْرٍ. وَأَخَذَ عَنْ: يُوْنُسَ.
عن الفَرَّاءِ تلميذ الكسائي أنه قال : "إنما تعلم الكسائي النحو على الكبر، وكان سبب تعلمه: أنه جاء يوما وقد مشى حتى أَعْيَا ، فجلس إلى الهَبَّارِين(قوم من قريش) فَقَالَ: قد عَيِيتُ . فقالوا له: أتجالسنا وأنت تلحن؟! فَقَالَ: كيف لحنت؟
فقالوا لَهُ: إن كنت أردت من التعب فقل أَعْيَيْتُ ، وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتدبير والتحيرة في الأمر فقل: عَيِيتُ - مخففة فأَنِفَ من هذه الكلمة وقام من فوره، فسأل عمن يعلم النحو. فأرشدوه إلى معاذ الهَرَّا ، فلزمه حتى أنفذ ما عنده، ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل وجلس في حلقته، فقال له رجل من الأعراب: تركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة، وجئت إلى البصرة؟ فقال للخليل : من أين أخذت علمك هذا ؟ فَقَالَ: من بوادي الحجاز، ونجد، وتِهامة. فخرج ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قِنِّينَةٍ حِبْرًا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه ، ولم يكن له همة غير البصرة والخليل ، فوجد الخليل قد مات وقد جلس موضعه يونس النحويّ ، فمرت بينهم مسائل أقر له يونس فيها وصدره موضعه" ..
قلت : هذه القصة على وجازتها فيها من العبر الكثير ، ومنها :
1-أن التحديات التي تواجه الإنسان في حياته أسباب لتقدمه وارتقائه ، لا سبب لتأخره وانحنائه ، وقد قال بعض حكماء الغرب : "أحب تحديات الحياة ؛ لأنها تعينني على التغيير من نفسي إلى الأحسن" ، فالإنسان الذكي يتعلم من أخطائه بحفظ الخطأ والصواب معًا ، وقد رأينا بالتجربة والممارسة أن الشيء الذي يخطيء فيه الطالب، ويبحثه ويحققه حتى يعرف الصواب ثم يبلغه يستحيل أن يكرر الخطأ فيه مرة أخرى بإذن الله .
2-أن لا يأنف طالب العلم عن الرجوع عن الخطأ ، قال علماؤنا : "الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل" .
3-فضل الرحلة في طلب العلم . وكان من السلف من يسافر سنة أو سنتين مشيًا على الأقدام ، وسيأتي ذكر ذلك في بعض القصص التالية إن شاء الله .
4-فضل كتابة العلم . والكتابة هي عماد طلب العلم ، وقد قلت من قبل :
إِنْ رُمْتَ إِتْقَانَ الْعُلُومِ فَحَصِّلْ خَمْسًا ... ادْرُسْ كَاتِبًا ، لَخِّصْ حَافِظًا ، وَبَلِّغْ دَرْسًا
5-كثرة الحقاد والحساد على العلماء خاصة من أهل بلدهم . ولله دَرُّ الشافعي إذ يقول :
كُلُّ العداوات قد تُرْجَى مَودَّتُها .... إلا عداوةَ مَنْ عاداك عَن حَسَدِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَحَّرَ فِي النَّحوِ، فَهُوَ عِيَالٌ عَلَى الكِسَائِيِّ.
قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: اجْتَمَعَ فِيْهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالنَّحوِ، وَوَاحِدَهُم فِي الغَرِيْبِ، وَأَوحَدَ فِي عِلْمِ القُرْآنِ، كَانُوا يُكْثِرُوْنَ عَلَيْهِ، حَتَّى لاَ يَضبِطَ عَلَيْهِم، فَكَانَ يَجمَعُهُم، وَيَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيٍّ، وَيَتْلُو، وَهُم يَضبِطُوْنَ عَنْهُ، حَتَّى الوُقُوفِ.
قَالَ إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: سَمِعْتُ الكِسَائِيَّ يَقرَأُ القُرْآنَ عَلَى النَّاسِ مَرَّتَيْنِ.
وَعَنْ خَلَفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَحضُرُ بَيْنَ يَدَيِ الكِسَائِيِّ وَهُوَ يَتْلُو، وَيُنَقِّطُونَ عَلَى قِرَاءتِهِ مَصَاحِفَهُم.
تَلاَ عَلَيْهِ: أَبُو عُمَرَ الدُّوْرِيُّ، وَأَبُو الحَارِثِ اللَّيْثُ، وَنُصَيْرُ بنُ يُوْسُفَ الرَّازِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بن مِهْرَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ أَبِي سُرَيْجٍ، وَأَحْمَدُ بنُ جُبَيْرٍ الأَنْطَاكِيُّ، وَأَبُو حَمْدُوْنَ الطَّيِّبُ، وعيسى بن سليمان الشيزري، وعدة.
وَمِنَ النَّقَلَةِ عَنْهُ: يَحْيَى الفَرَّاءُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَخَلَفٌ البَزَّارُ.
وَلَهُ عِدَّةُ تَصَانِيْفٍ، مِنْهَا: "مَعَانِي القرآن"، وكتاب في القراءات، وَكِتَابُ "النَّوَادِرِ الكَبِيْرِ"، وَمُخْتَصَرٌ فِي النَّحْوِ، " المتشابه في القرآن " رسالة في و " ما يلحن فيه العوامّ - وَغَيْرُ ذَلِكَ.
وَقِيْلَ: كَانَ أَيَّامَ تِلاَوَتِهِ عَلَى حَمْزَةَ يَلْتَفُّ فِي كِسَاءٍ، فَقَالُوا: الكِسَائِيَّ.
ابْنُ مَسْرُوْقٍ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ الكِسَائِيُّ: صَلَّيْتُ بِالرَّشِيْدِ، فَأَخْطَأْتُ فِي آيَةٍ، مَا أَخْطَأَ فِيْهَا صَبِيٌّ، قُلْتُ: لَعَلَّهُمْ يَرْجِعِيْنَ، فَوَاللهِ مَا اجْتَرَأَ الرَّشِيْدُ أَنْ يَقُوْلُ: أَخْطَأْتَ، لَكِنْ قَالَ: أَيُّ لغة هذه? قلت: يا أمير المؤمنين! قد يعثر الجواد. قال: أما هذا فنعم.
وَعَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الفَرَّاءِ: سَمِعْتُ الكِسَائِيَّ يَقُوْلُ: رُبَّمَا سَبَقَنِي لِسَانِي بِاللَّحْنِ.
وَعَنْ خَلَفِ بنِ هِشَامٍ: أَنَّ الكِسَائِيَّ قَرَأَ عَلَى المِنْبَرِ: {أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا} [الكهف: ٣٤] ، بِالنَّصْبِ، فَسَأَلُوْهُ عَنِ العِلَّةِ، فَثُرْتُ فِي وُجُوْهِهِم، فَمَحَوْهُ، فَقَالَ لِي: يَا خَلَفُ! مَنْ يَسْلَمُ مِنَ اللَّحْنِ؟
وَعَنِ الفَرَّاء، قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّمَ الكسائي النحو علي كبر، ولزم مُعَاذاً الهَرَّاءَ مُدَّةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الخَلِيْلِ.
قُلْتُ: كَانَ الكِسَائِيُّ ذَا مَنْزِلَةٍ رَفِيْعَةٍ عِنْدِ الرَّشِيْدِ، وَأَدَّبَ وَلَدَهُ الأَمِيْنَ، وَنَالَ جَاهاً وَأَمْوَالاً، وَقَدْ تَرجَمتُهُ فِي أَمَاكِنَ. دخل الرشيد يوما على الكسائي وهو لا يراه، وكان الكسائي معلما لولديه الأمين والمأمون، فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدها، فنهض الأميران بعجلة ووضعا النعل بين رجلي الكسائي، بعد وقت جلس الرشيد مجلسه وقال:
- يا كسائي أي الناس أكرم خدما؟
قال الكسائي: - أمير المؤمنين أعزه الله.
رد الرشيد بصدق النية، وطيبة القلب، وباحترام أهل العلم والعلماء:
- بل "الكسائي" يخدمه الأمين والمأمون ، وحدثهم بما رأى.ما أعظم صنيع كلمات الهباريين؛ إذ حصدت للعربية رجلا من روادها؛ وأيقظت داخله نهم العلم، فهو يغرف منه غير شبع؛ فما إن اطمأن إلى أنه قد أنهى ما عند معاذ الهراء حتى خرج إلى البصرة؛ ليلقى إمامها الخليل، ويجلس في حلقته؛ ينصت إليه؛ ويحفظ ما قال؛ وبينا هو كذلك إذ استعتبه رجل قائلا: "تركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة وجئت إلى البصرة، فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة؛ فخرج ورجع وقد أنفد خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ.
رجع صاحبنا إلى البصرة ثانية يقصد الخليل، لكن البصرة قد تغير حالها، كما أن صاحبنا قد تغير حاله فضمن فؤاده ما سمع من الأعراب أهل الفصاحة حتى امتلأت ذاكرته، وامتلأت كذلك رقاعه التي دوَّن عليها، ونفدت أحباره في تدوين ما سمعه.نعم؛ تغير حال البصرة بموت الخليل بن أحمد؛ وما أدراك ما الخليل بن أحمد؟ رأس اللغة والنحو في عصره، وأستاذ أساتذة المدرستين الكبيرتين الكوفة والبصرة.
مات الخليل، ولم يمت علم الخليل، ولم تنته حلقة درسه؛ إذ ارتقاها يونس بن حبيب البصري؛ ليبلغ العلم كما كان يبلغه الخليل.
وجاء صاحبنا يسأل عن الخليل فأخبر بموته؛ فجلس يستمع ليونس بن حبيب، لكنه هذه المرة لم يكن مجرد طالب علم؛ فهو رجل قد ضم بين جنبيه علم معاذ الهراء، ونقحه بما أخذ عن الخليل، ثم إنه قد عاشر أعراب البادية؛ فأصلح عجمة لسانه، وعرف طبائع الفصحاء في الكلام، وحفظ عنهم ما حفظ، ودون عنهم ما دون.
وقف صاحبنا موقف النظير من يونس بن حبيب، ودارت بينهما مسائل ومناظرات «أقر له يونس فيها، وصدره موضعه»
قدر لصاحبنا أن يشيع أمره، وينتشر علمه، فهيئت له الأسباب؛ فها هو ذا الخليفة المهدي أبو هارون الرشيد يأتي بمؤدب لهارون، ليعلمه، فدعاه يوما المهدي وهو يستاك؛ فقال: كيف تأمر من السواك؟ فقال: استك يا أمير المؤمنين فقال المهدي: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال: التمسوا لنا من هو أفهم من ذا؛ فقالوا: رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة، قدم من البادية قريبا فكتب بإزعاجه من الكوفة، فساعة دخل عليه قال: يا علي بن حمزة، قال: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: كيف تأمر من السواك؟ قال: سُكْ يا أمير المؤمنين، قال: أحسنت وأصبت وأمر له بعشرة آلاف درهم، يا للأقدار!! صار الكسائي مؤدبا لابن الخليفة، ثم صار مؤدبا للخليفة؛ هارون الرشيد، ومؤدبا لابنيه – بعد ذلك – الأمين والمأمون.
ما أغرب أثر تقلب الجديدين! فمن كان بالأمس القريب يوجَّه من الهباريين للفصاحة أصبح اليوم معلما للفصاحة، من كان منطقه بالأمس متهما باللحن والخطأ؛ صار اليوم حجة على الفصيح والغريب والجائز والواجب والممتنع، وهذا هو صنيع العلم بأهله. وازدادت مكانة صاحبنا بعد موت الخليفة المهدي، وتولي هارون الرشيد الخلافة؛ فهارون تلميذه، والكسائي -لا شك - ذو حظوة عند الرشيد معلومة الأسباب.
وقد كان بعض العلماء يغبط الكسائي على هذه المكانة التي كان يحظى بها عند الخليفة؛ فيروى أن القاضي أبا يوسف – رحمه الله – كان يقع في الكسائي ويقول: إنما يحسن شيئا من كلام العرب؛ فبلغ الكسائي ذلك؛ فالتقيا عند الرشيد فسأله الكسائي: ماذا تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؟ قال: واحدة، قال: فإن قال لها: أنت طالق أو طالق أو طالق؟ قال: واحدة، قال: فإن قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق؟ قال: واحدة؛ قال: فإن قال لها: أنت طالق وطالق وطالق؟ قال: واحدة؛ قال الكسائي: يا أمير المؤمنين؛ أخطأ يعقوب في اثنتين وأصاب اثنتين.
أراد صاحبنا أن يبرهن للقاضي أبي يوسف أن القضاء الذي هو صنعة أبي يوسف لا يستقيم أمره إلا بالنحو، فالسؤال الذي وجهه الكسائي في الفقه والقضاء، ولا جواب له إلا بالنحو، وكانت هذه عادة صاحبنا في مناظراته مع القاضي أبي يوسف، إلى أن جعل أبا يوسف يمدح العربية والنحو.
طفق صاحبنا بعد أن لاحظ خطأ أبي يوسف يحلل له المسائل التي سأله فيها تحليلا نحويا دلاليا، فقال: «أما قوله: أنت طالق طالق طالق فواحدة، لأن الثنتين الباقيتين تأكيد كما يقول أنت قائم قائم قائم، وأنت كريم كريم كريم، وأما قوله: أنت طالق أو طالق أو طالق فهذا شك، فوقعت الأولى التي تتيقن، وأما قوله: طالق ثم طالق ثم طالق فثلاث لأنه نسق، وكذلك طالق وطالق وطالق.
العالم البحر:
حصّل الكسائي خلال ارتحاله العلمي علما كثيرا، ولقد كانت كلمات الهباريين التي قالوها في نقد لحنه فاتحة خير عليه لم ينقطع، فقد ألم بعلوم شتى، ولم يكتف بالوقوف عند حد النحو.
ويدلنا على ذلك ما رواه صاحب وفيات الأعيان عن السجستاني إذ يقول: «قال محمد بن الحسن الأزدي: حدثنا أبو حاتم قال: وفد علينا عامل من أهل الكوفة ولم أر في عمال السلطان أبرع منه، فدخلت عليه مسلّمًا فقال لي: يا سجستاني، من علماؤكم بالبصرة قلت: الزيادي أعلمنا بعلم الأصمعي، والمازني أعلمنا بالنحو، وهلال الرأي أفقهنا، والشاذكوني من أعلمنا بالحديث، وأنا - رحمك الله - أنسب إلى علم القرآن، وابن الكلبي من أكتبنا للشروط. قال: فقال لكاتبه: إذا كان غدًا فاجمعهم إليّ، قال: فجمعنا فقال: أيكم المازني، فقال أبو عثمان: ها أنا ذا، قال: هل يجزي في كفارة الطهارة عتق عبد أعور؟ قال المازني: لست صاحب فقه، أنا صاحب عربية، قال: يا زيادي، كيف يكتب بين بعل وامرأة خالعها على الثلث من صداقها؟ قال: ليس هذا من علمي، هذا من علم هلال الرأي، قال: يا هلال، كم أسند ابن عون عن الحسن قال: ليس هذا من علمي، هذا من علم الشاذ كوني، قال: يا شاذ كوني، من قرأ: (تثنوني صدورهم). قال: ليس هذا من علمي، هذا من علم أبي حاتم، قال: يا أبا حاتم، كيف تكتب كتابًا إلى أمير المؤمنين تصف خصاصة أهل البصرة، وما أصابهم في الثمرة، وتسأله لهم النظر والنَّظِرة قلت: لست صاحب بلاغة وكتابة، أنا صاحب قرآن؛ قال: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم خمسين سنة لا يعرف إلا فنًّا واحدًا حتى إذا سئل عن غيره لم يَجُل فيه ولم يمُر، لكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن هذا كله لأجاب....
لم تقف مناظرات صاحبنا عند القاضي أبي يوسف أو يونس بن حبيب البصري، بل إن له مناظرات ممتعة مع كثير من العلماء، منها مناظرته مع سيبويه التي عُرِفَتْ بالمسألة الزنبورية في النحو.
وكانت لصاحبنا مناظرات مع اليزيدي وصولات وجولات اتسمت بالتنافس القوي الذي كان مرده إلى أن الكسائي قد آل به الأمر إلى أن يؤدب الأمين، وأن يؤدب اليزيدي المأمون.
ومن المناظرات التي دارت بينهما ما روي من أن الرشيد جمع بين الكسائي وأبي محمد اليزيدي، يتناظران في مجلسه، فسألهما الكرماني عن قول الشاعر:
ما رأينا خَرِبًا يَنـقر عنه البَيضَ صَقْرُ لاَ يَكُونُ العَيرُ مُهرًا ،لا يكون؛ المُهْر مُهرُ، فقال الكسائي: يجب أن يكون المهر منصوبًا على أنه خبر كان، ففي البيت على هذا إقواء. فقال اليزيدي: الشعر صواب؛ لأن الكلام قد تم عند قوله: لا يكون الثانية، ثم استأنف، فقال: المهر مهر، ثم ضرب بقلنسوته على الأرض، وقال: أنا أبو محمد. فقال له يحيى: أتكتني بحضرة أمير المؤمنين؟ فقال الرشيد: واللّه، إن خَطَأَ الكسائي مع حسن أدبه لأحب إلي من صوابك مع سوء أدبك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن حلاوة الظفر أذهبت عني التحفظ فأمر بإخراجه.أذهبت حلاوة الظفر عن اليزيدي التحفظ؛ ففرح بما كان منه أمام عالم الكوفة وأستاذها، وما كان التنافس ليحمل اليزيدي على بغض الكسائي، بل كان يعرف له قدره ويجله، وليس أدل على ذلك من الأبيات التي قالها اليزيدي في رثاء الكسائي بعد أن خرج الأخير مع هارون الرشيد إلى الري، وكان بصحبتهما محمد بن الحسن القاضي صاحب أبي حنيفة، فمات القاضي محمد بن الحسن، ومات الكسائي في بلد واحد، وهو قرية رنبويه بالري، وكانا متوجهين مع الرشيد إلى خراسان، فقال الرشيد: «دفنا الفقه والنحو بالري»؛ وباغت الخبر اليزيدي فأحزنه، وحرك أشجانه، فقال:
تصــرَّمت الدُّنْيَــا فَلَيْـسَ خــــلودُ وَمَا قد يُـرَى من بهجةٍ سيبيدُ
أَسِيتُ على قَاضِي الْقُضَاة محمدٍ فأذريتُ دمعـاَ والفـؤادُ عمــيدُ
وقلتُ إِذا مَا الخطبُ أشكلَ مَنْ لنا بإيضــاحه يوماً وَأَنت فقــيدُ
فأوجعني موت الْكِسَائي بعده وكادت بِي الأرضُ الفضاءُ تَميدُ
هما عالِمــان أوديا وتخــرَّما وَمَـا لَهمــا فِي العــالمــين نَـدِيــدُ
فحزني إن تخطر على القلب خطرة بذكرهما حتى الممات جديدُ
قَالَ الرشيد: أحسنتَ يَا بصريّ، قد كنت تظلمه فِي حَيَاته وأنصفته بعد مَوته
سَارَ مَعَ الرَّشِيْدِ، فَمَاتَ بِالرَّيِّ، بِقَرْيَة أرَنْبُوية، سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِيْنَ وَمائَةٍ، عَنْ سَبْعِيْنَ سَنَةً. وَفِي تَارِيْخِ مَوْتِه أقوال. فهذا أصحها.
قضايا لغويّة ومسائل نحوية
كتاب (جناية سيبويه)
الجهل باللغة.....!
ليس الغرض من هذه النظرات مصادرة حقّ الآخرين في الكتابة أو النقد، ولو كان المنتَقَدُ قواعد اللغة، أو اللغة نفسها، فالعربيّة لغة هذه الأمّة، وأهمّ مقومات بقائها؛ حظيت عند الأوائل بما لم تحظ به لغة أخرى، ومن حقّ أبنائها في كلّ زمان أن يقولوا فيها ما يعتقدون أنّه الخير والصلاح لها، فهم أهل مكّة، وهم أدرى بشعابها، بيد أنْ الناظر في أمرِ مَن يدّعون النقد والإصلاح تدخله الريبة فيما يكتبون، وينازعه الشك في أنّ أهل مكّة اليوم –إن كانوا من أهلها حقّاً- ما زالوا يعرفون شعابها، أو يعرفون مكّة نفسها.
ولا ريب أنّ الجهل بأمر هذه الشعاب فيه من الخطر ما فيه، وأقلّ ذلك أنّه يفضي إلى ضرب من العشوائيّة والتيه، هذا إذا أحسنّا الظنّ بهم وبما يصنعون، وإلاّ فإنّ أمراً قد دُبّر بليل، والغرض ممّا يلهثون وراءه لا يخفى على أحد، فالتخلص من العربيّة وقواعدها، وإحلال العاميّات محلّها مقدّمة لمحو أبرز معالم شخصيّة الأمّة، وقطع حاضرها عن ماضيها، وجعلها جسداً واهناً لا طاقة له على الصمود أو البقاء تمهيداً للإجهاز عليها.
وبين أيدينا نموذجٌ ممّا يكتبه هؤلاء، تجاوز فيه المؤلف حدود النقد إلى الهدم والاجتثاث.وما كان هذا الكتاب ليستحق الردّ لو نظرنا إلى ظاهره، وهو نقد النحو العربيّ ممثلاً بسيبويه، ففيه من التهافت ما يغني عن الردّ، وقديماً قالوا "الرديء لا يساوي حمولته"، بيد أنّ مراميه أبعد من ذلك، وهو ما سيظهر للقارئ بجلاء.
هذا الكتاب الذي سمّاه صاحبه "جناية سيبويه" تعدَّدت غاياته، وأقربُها نقد النحو العربيّ، إن جاز لنا أن نسمّي ما جاء فيه نقداً.
والظاهر أيضاً من عنوانه أنّ مؤلّفه لا يقرّ بتسميته نحواً عربيَّاً، ولذا عزاه إلى سيبويه، مع أنّه لم يطلّع على كتاب هذا الأخير ولا وقف على شيء من كلامه، وأغلب الظنّ أيضاً أنّه لم يطّلع على مصنفات النحويين ولم يجاوز مقدّمات بعضها في أحسن الأحوال.ومهما يكن فإنّ النحو الذي أراد الكاتب نقده، وبعبارة أدقّ هدمه واطّراحه، ليس هو تلك الأصول التي بنى عليها النحاة قواعدهم، ولا منهجهم في بناء القاعدة، فهذا ما لا طاقة له به، بل اتجه –وهذا كلّ ما لديه- إلى ما يمكن أن نسميه نماذج من التطبيق الإعرابي، يقف المرء عليها في كتب اللغة العربيّة التي صُنّفت لأغراضٍ تعليميّة، ولا سيّما الكتب المدرسيّة، وإلى بعض مصطلحات الإعراب التي استقرّت عند المتأخرين والمعاصرين ممّا يصاحب عادةً مثل تلك النماذج، ظنّاً منه أن هذا هو نحو سيبويه أو النحو العربيّ. ولقد اصطنع المؤلّف في إطلالته شيئاً من الحياء، فأسرَّ أنّه كان متردّداً في نقد النحو، وينتابه الخوف "لأنّ السادة العلماء الأفاضل ومن بعدهم من النحاة قد ربطوه بالقرآن الكريم، فجعلوه كالقرآن لا يحقّ لأحدٍ نقده أو معارضته".
ولا يخفى ما في هذا التردّد والخوف من تكلّف، لأنّه –أي المؤلّف- يعلم أنّ ما كتبه المعاصرون في نقد النحو العربي وتوجيهه أكثر من أن يحاط به، ولم نسمع عن واحدٍ من هؤلاء أنه استتيب أو طلب منه الرجوع عمّا كتب، ولعله يعلم أيضاً أنّ ابن مضاء القرطبي لم يتردّد قبله بألف سنة، ولم يعتوره خوف حين نقد النحاة في كتابه المشهور "الردّ على النحاة" ولعلّه لم يَبْلُغه أن سيبويه تعرّض للنقد من قبل بعض النحويين كالمبرّد، وهو من مدرسته ومن أتباعه، ولا يخفى على أحد انقسام النحاة إلى طوائف ومدارس حتّى ألّفت في خلافاتهم المطوّلات. ولو أنّهم ربطوا النحو بالقرآن لما انتهى إلينا شيء من هذا كلّه، ولما رأينا اجتراء بعض النحويين على القرّاء وقراءاتهم أحياناً فلم يسلم هؤلاء من النقد، ولم يتكلف منتقدوهم الورع. فلا داعي إذاً لهذا الذي تكلّفه إن كان ما يضمره خيراً للّغة وقواعدها.
لكن من يمضي في قراءة المقدّمة –وهي الفصل الأوّل من الكتاب- يدرك من الوهلة الأولى أنّ الرجل لا يبتغي نقداً ولا إصلاحاً، بل هدماً كاملاً، لا لقواعد العربيّة فحسب، بل للعربيّة نفسها، تلك اللغة التي ما فتئ ينعتها بالقِدم، وأنّ "مفردات أجدادنا العرب القدامى غير كافية لاستيعاب كافة المسميات في أيّامنا المعاصرة"، ولذا –والدعوة له- لا بدّ من اعتماد اللهجات بديلاً لهذه اللغة، كما سيأتي بعد قليل. ولا ريب أنّه كلام غريب لا يصدر إلاّ عمّن ينظر إلى اللغة على أنّها كائن جامد، وإلاّ فكيف يطلب من لغة أن تستوعب منذ نشأتها "كافة المسميات في أيامنا المعاصرة".
إنّ اللغة كائن حيّ، وهي في كل مرحلة من مراحل حياتها تستوعب بفضل من يتكلمون بها مسميّات عصرها، وإنْ مسَّها شيء من الجمود أو الوهن فمِن هؤلاء وليس منها، ولعلّ ما في العربيّة من علائم الخصوبة يجعلها أكثر اللغات قدرة على استيعاب كلّ جديد. وكان حريّاً به أن يشعر بشيء من الغيرة عندما يرى لغة كالعبريّة، وهي لغة غابت عن ساحة التخاطب أكثر من ألفي سنة، كيف استطاع متعلّموها أن ينهضوا بها ويجعلوا منها لغة تواكب العصر، ولعلّ الذي لا يعرفه المؤلف أن كتب النحو العربي كانت متكأً لهؤلاء في بناء قواعد لغتهم، فهل هذا مما جناه سيبويه على غير العربيّة أيضاً، أم أنّها وجدت قوماً يهتمون بلغتهم ويُعلون من قدرها، لأنها الرابط المتين لهم؟؟!! لا كالذي تلقاه العربية من أبنائها.
ومهما يكن فقد عرض الكاتب في المقدّمة الأسباب التي تدعوه إلى اطّراح قواعد العربيّة، ويمكن إجمالها فيما يأتي:
1-إنّ هذه القواعد غير منطقيّة ولا عقلانية، طالباً من "السادة النحاة وعلماء اللغة أن يوسعوا صدورهم، ويشاركوه في قراءة الكتاب ليعرفوا إذا ما كانت قواعد لغتنا معقلنة أو منطقيّة" آملاً "أن يحكّموا عقولهم وضمائرهم".
ولا بأس أن ننتظر حتى يلقي عصاه، فلعلّ قواعدنا، كما يزعم المؤلف، هي على الوصف الذي يراها عليه.
2-إنّ هذه القواعد "لم تستطع أن تؤدّي دورها المطلوب، بينما استطاعت لغتنا العريقة والجميلة!! أن تنتشر لتختلف اللهجات فيها"، وعليه فنحن لا نحتاج إلى "أن نتكلّم بلغة منمّقة مقعّدة" بل يكفينا اعتماد اللهجات، لأنّ الأذن تألفها، واللهجة المثلى التي ارتضاها المؤلف أمرها هيّن، إذ "يمكن لأي فرد عربيّ أن يفهم الحوار في الأفلام والتمثيليات والبرامج المصريّة، علماً أنّها تتكلم اللهجة المصريّة المحكيّة البعيدة كليّاً عمّا يسمّونه اللغة العربيّة الفصحى".
ولا ريب أنّ دعوته إلى اعتماد اللهجات ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، والخوض في هذه المسألة هو من المعاد المكرور، لكنّ الذي غاب عنه، وربما عن غيره من أصحاب هذه الدعوة، أنّ القواعد لم تكن في يومٍ من الأيّام سبباً في نشوء اللهجات، فلهجات العربيّة قديمة، عاشت وترعرعت قبل أن تولد القواعد. وأمّا لهجة الأفلام والتمثيليات المصريّة- ولكي لا نظلمه، فقد اختار لنا القديمَ منها –ففيها راحة للبال لا شك، لكننا لسنا بحاجة بعدها إلى لغة علم أو اقتصاد أو سياسة.. فنحن أمّة تفيض جوانحنا عاطفة، وما في هذه الأفلام قد يروي ما عندنا، وأمّا مَن لا هوى له في تلك الأفلام فلعلّ المؤلف سينتخب له لهجة أو لُغَيّة أخرى، وأفلاماً غيرها يميل إليها ذوقه وينهض بها لسانه!!.
3-إنّ تعقيد القواعد سببٌ رئيسيّ لعدم انتشار العربيّة:
ولا ندري علام استند الكاتب في مثل هذا الحكم، فكأنّه يستخفّ بعقل القارئ، لأنّ اكتساب اللغة لا يشترط فيه دَرْسُ القواعد وتعلّمها، وإلاّ فكيف يكتسب الطفل لغته، وكيف يكتسب العامل الأميّ غير لغته حين يقيم في بلدٍ آخر.وإن سلّمنا بما يقول فكيف نفسّر انتشار العربيّة بعد الفتوح الإسلاميّة خارج جزيرة العرب على ألسنة من دخلوا الإسلام من غير العرب حتى قبل ظهور القواعد.
4-إنّ هذه القواعد لم يضعها العرب "لأنّ سيبويه كونه فارسي الأصل قام بوضع قواعد لأمثاله في ذلك الوقت كي لا يلحنوا في لفظ كلمات اللغة العربيّة".
ومثل هذا الكلام تشتمّ منه رائحة العصبيّة المقيتة، ولا يصدر اليوم إلاّ عمّن لا يريد الخير لأمّته، وإلا فكثيرٌ من علماء اللغة والنحو والطبّ والفلسفة والدين والاجتماع وكثيرٌ من أدبائنا وشعرائنا ليسوا في أصولهم عرباً، فهل ننسلخ عنهم ونتّبرأ من إبداعهم وإن كان بالعربيّة! ألم يذب هؤلاء في معين الثقافة العربيّة، فأصبحوا جزءاً من هذه الأمّة وتراثها!.
والفرق بين الكاتب الذي يبدي حرصه على عروبته وعروبة لغته وبين هؤلاء العلماء (الأعاجم) = أن الأوّل شديد الهزء بلغته وقواعدها، بل تراه يمسك بتلابيب أشعر شعرائها قديماً ليسخر من شعره ومن صوره الفنيّة، أمّا هؤلاء الذين يهاجمهم فقد تغنّوا بالعربيّة وبُهروا بها، ورأوا فيها سحراً، ألم يستمع إلى ابن جنّي- وهو العالم اللغوي الروميّ الأصل الذي بهرت آراؤه في اللغة المعاصرين- وهو يقول: "إنني إذا تأملتُ حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدتُ فيها من الحكمة والدقّة والإرهاف والرقّة ما يملك عليّ جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر".
ثمّ من ذا الذي يصدّق أنّ رجلاً بمفرده كسيبويه له مقدرةٌ على وضع قواعد للغة مترامية الأطراف كالعربيّة، وما من عذر للكاتب إلا جهله بتاريخ النحو العربي ومعرفة المراحل التي مرّ بها حتى انتهى إلى سيبويه، ولعلّه لو تصفح كتاب هذا الأخير لعرف أسماء بعض العلماء الذين صيغت على أيديهم قواعد العربيّة. ومن يصدّق أيضاً أنّ كتاب سيبويه وضع للأعاجم كي لا يلحنوا في لفظ الكلمات، أم تراه يظنّه من كتب (لحن العامّة)، ونعذره مرّة أخرى لأنّه كما أسلفت لم يطّلع على هذا الكتاب ولا على كتب لحن العامّة، ولا يعرف شيئاً عن مضامينها.
5-القرآن الكريم لم يكن يتّبع قواعد سيبويه، أو بعبارة أخرى وهي له أيضاً: لم يخضع لقواعد سيبويه.
وسوف ننتظر أيضاً ما كتبه في الفصول اللاحقة لنرى إن كان لديه برهان ما يقول.
6-إنّ قواعد العربيّة تقوم على الشكل والاهتمام بحركات أواخر الكلمات، دون الالتفات إلى المضمون، ولم يسأم الكاتب من تكرار مثل هذا الكلام في أكثر صفحات كتابه ، ويكفي أن أسوق ههنا مثالاً واحداً يستبين منه قصده، وذلك قوله: "عندما رصد سيبويه وأتباعه كلام العرب كقولهم: "في القوم عالمٌ" وجدوا "عالم" مرفوعة فلم يكن لهم خيار واعتبروها مبتدأ، وهكذا تتوالى التخريجات التي تعتمد الحركة الأخيرة للكلمة لا المعنى، وتعتمد الوهم لا الحقيقة". ولمّا كانت هذه الحركات خالية الدلالة عنده أعلن بما يشبه الصياح إنّه "ليستوي عندي إذا قلنا: كان أحمدُ فائزاً، أو قلت: كان أحمدَ فائزٌ. أو قلت: كان أحمدُ فائزٍ، أو قلت: كان أحمدْ فائز، ولا حاجة إلى رفع أو نصب أو جرّ ".
ولا يخفى أنّ الرجل ههنا دلّ على خبيئة نفسه ولم يستطع إخفاء ما يضمره من تجاوز هدم القواعد إلى هدم اللغة نفسها، لأنّ الحركات هي صنع المتكلّم لا النحويّ، ونحن لا يسعنا إلاّ أن نقبل منه قوله "ليستوي عندي"، فهو أمرٌ يخصّه وحده، وإلاّ فاللغة أكثر منطقيّة من هذه الفوضى التي ينادي بها، لأنّ حركات الأواخر لم تكن في يومٍ من الأيام أصواتاً تزيّن بها الألفاظ بل هي دوالُّ أو أدوات يُتوصّل بها إلى فهم مقاصد الكلام، فالرفع عند العربيّ –لا المؤلّف- علامة الإسناد (الفاعليّة والابتداء) والنصب علامة الفضلة (المنصوبات) والجرّ علامة الإضافة أو وجود حرف جرّ.
ولو كان الشكل أو حركة الأواخر سيطرا على أذهان النحاة ما وجدناهم يفرّقون بين أنواع المنصوبات، ويقولون: حال وتمييز ومفعول مطلق ومفعول لأجله ومفعول به ومفعول فيه.. وهي تقسيمات قوامها المعنى لا غير، ولما فرّقوا بين المرفوعات، وقالوا: مبتدأ وخبر وفاعل، ولما فرّقوا بين مجرورٍ بالحرف أو مجرورٍ بالإضافة.
ولو كانت حركة الأواخر هي التي صنعت الفكر النحوي لوجدنا النحاة يسلّمون بهذا الشكل لا يحيدون عنه، ولما احتكموا إلى المعنى، ولا أخذوا بقياسٍ أو سماع، نعم لو سلموا به لما اختلف حكمهم على الجار والمجرور في الآيات (وما ربُّك بظلاّم للعبيد( [فصلت: 46]، و (ما اتخذ الله من ولد) [المؤمنون: 91]، و ( هل من خالق غير الله( [فاطر: 3]، و (ما جاءنا من بشير( [المائدة: 19].
فالألفاظ الواقعة بعد أحرف الجر ههنا مجرورة، بيد أنّ النحاة لم يكتفوا بهذا الشكل وحركة الأواخر، بل أدركوا بالفطرة اللغويّة السليمة التي يفتقر إليها المؤلف أن أحرف الجر هذه لم تؤدّ معاني خاصّة بها كما هي الحال عليه مع حروف الجر، بل جيء بها لضربٍ من التوكيد فحكموا – من جهة المعنى –على (ظلاّم) بأنّها خبرٌ لـ (ما) العاملة عمل (ليس)، وعلى (ولد) بأنّها مفعول به، وعلى (خالق) بأنها مبتدأ، وعلى (بشير) بأنها فاعل... ولو كان الشكل معوّلهم لما بحثوا عن مواضع هذه الألفاظ أو عن وظائفها في سياق جُمَلها. ولا شكّ أنّ هذا الذي سمّاه الكاتب شكلانيّة القواعد هو الذي جعل سيبويه عنده من الجناة مع أنّ هذا الأخير بريء مما رُمي به، ولو تصفحنا كتابه لوقفنا على ما لا يحصى من الشواهد التي تظهر أنّه بنى قواعده على المعنى لا الشكل، ولعلّ مثالاً واحداً من كتابه يثبت ذلك ويجعلنا نتساءل بعده عن الجاني الحقيقي.
قال سيبويه معلقاً على بيت امرئ القيس:
ولو أنّما أسعى لأدنى معيشة * * * * * كفاني ولم أطلب قليل من المال
"فإنما رفع [أي قليل] لأنّه لم يجعل القليل مطلوبه، وإنّما كان المطلوب عنده الملك، وجعل القليل كافياً، ولو لم يُرِد ذلك ونصب فَسَد المعنى".
والذي أراده سيبويه ههنا أنّه لا يصحّ أن تجعل كلمة (قليل) من باب التنازع، بحيث تكون مطلوبة للفعلين المتقدّمين (كفى) و (أطلب) فيصلح فيها الرفع على الفاعليّة للأوّل، والنصب على المفعوليّة للثاني، لأنّ الشاعر –وهو ملك- لا يطلب القليل بل المُلْكَ الذي ضاع منه، أمّا المال فيكفيه منه القليل، ولذا وجب أن تكون كلمة (قليل) مرفوعة على أنها فاعل (كفى)، ولو نصبت على المفعوليّة لـ أطلب فسَد المعنى. ولا ريب أنّ المؤلف سيشعر بشيء من الخيبة لأنّ تفكير سيبويه لم يجاوز المعنى، وبنى ما بناه عليه وحده.
هذا ما عرض له مؤلّف الكتاب في فصله الأوّل، أمّا في الفصول اللاحقة فقد شرع فيما يمكن أن يسمّى نقداً جزئيّاً تفصيلياً لقواعد العربيّة.
ولمّا كان تتبّع جميع ما في الكتاب يُثقل على القارئ رأيت أن أقتصر على الفصل الثاني لأنّ ما فيه يكفي لإظهار قصده، والفصول اللاحقة ما هي إلاّ تكرار. ويبدو لي أيضاً أن المؤلف زاده من العربيّة قليل، لكنْ تملّكته شهوة الشهرة بالمخالفة والردّ، وظنّ أنّ أسلوب الخطابة، والهزء بالقواعد وأهلها، والإكثار من العجب والاستغراب والاندهاش، قد يلقى صدى عند قارئ استخف به أيّما استخفاف، لكنّه كان واهماً فما جاء به ما هو إلاّ زيف لا يسلم عند أدنى نظر، وإن دلّ على شيء –سوى ما يضمره- فإنه يدل على جهلٍ بالعربيّة وقواعدها.
------------------
سمّاه المؤلف "الكلمات والجمل"، تناول فيه بالنقد: الكلمة، الجملة الاسميّة (الأفعال الناقصة!!، الأحرف المشبهة بالفعل)، الجملة الفعلية (الأفعال بحسب زمن وقوعها، حسب اكتمالها، حسب مفعولها، حسب تجرّدها، الأفعال المزيدة، حسب صرفها، حسب صحّتها، حسب فاعلها، بحسب إعرابها، الفاعل).
*اعتراضات المؤلّف في الميزان:
أولاً: الجملة الاسميّة:
1-مصطلح "الجملة الاسميّة: فيه نظر:
يرى الكاتب أنّ الجملة الاسميّة يجب أن يقتصر مفهومها على المعتقدات أو الحقائق العلميّة الثابتة التي لا تتبدّل بتبدّل الزمن، مثل (الأرض كرويّة) و (الله عظيم)، أمّا قولنا (الطفل سعيد) و (زيدٌ قويّ) فلا يجوز أن يسمّى جملة اسميّة، لأنّ "مثل هذا التركيب يغيب عنه تأثير الزمن ويفيد الديمومة والثبات؛ إذ لا يعقل أنّ الطفل كان سعيداً، وهو سعيدٌ الآن، وسيبقى سعيداً في المستقبل، وهذا لا ينطبق على صفات البشر"، وعليه "فمصطلح الجملة الاسميّة من حيث الدلالة والمعنى يحتاج إلى إعادة نظر" .
وهذا الذي انتهى إليه هو من السذاجة بمكان، إذ لا يمكن لأحد أن يحكم على تلك الجمل التي سردها، من حيث زمنها ودلالتها، بمعزل عن السياق، أي لا بد أن تكون ضمن كلامٍ يفهمه المتكلّم والسامع، وعليه فإنّ ما تَوَهَّمه من غياب الزمن في قولنا "الطفل سعيد" غير صحيح، لأنّ زمن الجملة مفهوم عند المتكلّم والسامع، وأنا حين أقول لِمَن هو أمامي: "السماء صافية" لا أقصد البتّة أنها كانت صافية وأنّها ستبقى إلى ما شاء الله كذلك، بل سيفهم مني، بالمشاهدة، أنّها لحظة راهنة، هي زمن التكلّم، طال أو قصر.
ولعلَّ الذي دفعه إلى توهّم الديمومة والثبات في قولنا "الطفل سعيد" اعتقاده أنّ الصفة المشبهة "سعيد" و "قويّ" تدلّ على الديمومة- هذا إذا أحسنّا الظنّ به وأنه سمع عمّا يسمّى بالصفة المشبهة- وهو اعتقادٌ غير صحيح، لأنّ من الصفة المشبّهة ما هو صفة عارضة، مثل "عطشان" و "شبعان" و "فَرِحٌ" و "سعيدٌ" ومنها ما هو ثابتٌ أو كالثابت، والثبوت أيضاً أمرٌ نسبي، فقد يلازم صاحبه، وقد ينفك عنه، وهذا ما عناه الرضيّ الأستراباذي حين قال: "الصفة المشبهة ليست موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة".
وأغلب الظن أنّ حكم الكاتب على مثل هذه التراكيب بعدم الصحّة، لخلّوها من الدلالة على الحقائق، وبالتالي فإنّ إطلاق مصطلح (الجملة الاسميّة) عليها خطأ=أمرٌ تسرَّب إليه من الإنكليزية التي تخلو قواعدها من هذا المصطلح وتستخدم ما يسمّى "المضارع البسيط" للدلالة على الحقائق الثابتة والمعتقدات، فرأى حينئذٍ أنّ إلباس العربيّة هذا اللبوس فيه نقدٌ أو إصلاحٌ للقواعد. والحقّ ما عليه نحاة العربيّة من أنّ الجملة الاسميّة هي التي صدرها اسم، سواءٌ دلّت على حقيقة ثابتة أم متغيّرة، وأمّا مسألة الزمن فيها فشيء مستفادٌ من "الخبر" وطبيعته الاشتقاقيّة غالباً، ومستفادٌ قبل كلّ شيء من السياق والقرينة.
---------------------
لا يجوز تعدّد الخبر:
اعترض الكاتب على مسألة تعدّد الخبر، لأنّ الخبر الأوّل "قام بالمهمّة" "والاسم بعده فقد وظيفته، فلم يعد يخبر عن المبتدأ".
ولا وجه لهذا الاعتراض، وهو اعتراضٌ قديم قال به بعض النحاة، لأنّ الخبر إنّما هو حكمٌ يطلقُ على المبتدأ، ومن المقبول عقلاً أن يطلق على الشيء أكثر من حكم، فنقول مثلاً: (بلدنا زراعيٌّ، صناعيّ) و (عنترةُ فارسٌ شاعر) ، ثمّ إنّ الخبر وإن تعدّدَ لفظاً يظلُّ واحداً من جهة المعنى ، فقولنا (بلدنا زراعي صناعي) أي: بلدنا جامعٌ لصفات مختلفة، وكذا المثال الذي بعده.
---------------------------------
-لا يجوز أن يتوالى مبتدآن:
فإذا قلت "المدينة شوارعها نظيفة" لم يجز لك أن تدّعي أن "المدينة" مبتدأ، وأنّ "شوارعها" مبتدأ أيضاً، "إذ كيف نسمح لأنفسنا أن نسميه [أي شوارع] مبتدأ ولم نبدأ به".ومثلُ هذا الكلام ينمّ عن ضعف الكاتب في فهم طبيعة الجملة الاسميّة، والعلاقة بين أجزائها، لأنّ المبتدأ في العربيّة لا يشترط فيه التقدم أو السبق دائماً وإن كان هو السابق من حيث المرتبة، بل هو المسند إليه الذي لم يتقدّمه عامل، ويؤلّف مع الخبر جملة اسميّة.والجملة التي توقّف عندها الكاتب هي من هذا النوع، إلاّ أنّها –في مصطلح النحاة- جملة كبرى تداخل إسنادها، ويعنون بالكبرى تلك الجملة التي يكون صدرها مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، وخبرها جملة لا مفرد، فيتحصّل فيها حينئذٍ إسنادان، لا إسنادٌ واحد. ففي المثال السابق أسند المتكلّم "نظافة الشوارع" إلى "المدينة"، فالمدينة مسندٌ إليه مبتدأ، ثمّ أسند النظافة إلى الشوارع، فالشوارع أيضاً مسندٌ إليه، مبتدأ. ولو تأملنا هذه الجملة الكبرى لرأينا أنها في الأصل جملة واحدة صغرى، لا مركبة، وهي: شوارعُ المدينة نظيفة، لكن المتكلّم قدّم من أجزائها ما هو موضع اهتمام عنده، وهو "المدينة"، وتقديمُ ما يعتقد المتكلمُ أهميته فاشٍ في اللغة الإنسانية لم تتفرد به العربيّة، فأصبحت الجملة "المدينة شوارع نظيفة"، وهي جملة مفككة لا رابط بين أجزائها، فأُصلحت بالضمير (ها)، فتداخل إسنادها، وسمّاها النحاة جملة كبرى توالى فيها مبتدآن. فالمسألة إذن لا تقوم على سبقٍ لفظي، بل هي علاقات إسناديّة قصد إليها المتكلّم، وليس للنحويّ إلاّ أن يصفها.حتّى لو سلّمنا بشرط التقدّم أو السبق الذي أراده الكاتب –وهو سبق لفظيّ شكلي- فإنّه متحقق في هذه الجملة الكبرى المكوّنة من جملتين، فكلّ من المبتدأين فيها هو المتقدم في جملته، والجملتان هما:
أ-المدينة شوارعها نظيفة.
ب-شوارع المدينة نظيفة.
------------------------
-لماذا المبتدأ اسم وليس فعلاً؟
"وماذا سيكون الفرق؟ أمورٌ لا يصح المنطق إلاّ برفضها من أساسها أصلاً" ولسنا ندري عن أي منطق يتحدّث، بل لسنا ندري إن كانت القواعد غايته أم اللغة نفسها، ولا يسعنا إلاّ أن نذكّره مرّة أخرى أنّ المبتدأ في كلام العرب هو ما يجري الحديث عنه، ولذا سمّاه النحاة مسنداً إليه أو محكوماً عليه، أو مُحدَّثاً عنه، وألفى هؤلاء بالاستقرار أنّ هذه الوصاف لا تكون إلاّ للاسم، أمّا الفعل فقد قادهم الاستقراء أيضاً إلى أنّه الجزء الذي يحمل الفائدة ويُخبر به عن المبتدأ أو يُحكم به عليه، فإذا قيل "زيد قام" فإننا بذلك إنّما نخبر عن (زيد) بالقيام، فزيد هو المبتدأ لأنّه المخبر عنه، و (قام) هو المخبر به وهو محل الفائدة ولذا سميّ خبراً، ولا أظن الفرق بينهما يخفى على ذي بصيرة.
ثمّ إنّنا لو سلّمنا بما يدعو إليه المؤلّف، وهو أن يكون المبتدأ فعلاً لآل الأمر إلى نتيجة حتميّة، وهي أنّ هذا المبتدأ (الفعل) لن يكون بحاجة إلى خبر، لأنّ الفعل في حدّ ذاته خبر لأنّه مُحَدَّث به، ثمَّ إن هذا المبتدأ (الفعل) لا بدّ أن يكون له فاعل- ولا أدري إن كان المؤلف يقبل ذلك أم أنه سيفرغ الفعل من فاعله أيضاً. ومهما يكن فسوف ننتهي إلى جملة فعليّة، تسمّى عنده مبتدأ وخبراً.ونسأله بعد ذلك: إذا كان الفعل مبتدأ فأين الخبر؟ ثمّ كيف نسميّه مبتدأ وهو يلبس ثوب الخبر؟
وإذا كان المبتدأ فعلاً فما الحكمة من استعمال العرب الجملة الاسميّة في كلامهم وما الفرق بين الجملة الاسميّة والفعليّة... أسئلة تترك للمؤلف وحده أن يجيب عنها.
-------------------------------
-لماذا يعلّق النحاة شبه الجملة بمحذوف تقديره "كائن" أو "موجود"؟
عندما نقول "الطفل في المنزل" "لماذا لا يكون الجارّ والمجرور متعلقين بخبر محذوف تقديره "مسجون" مثلاً أو "حزين" أو "سعيد" في البيت، أو غير ذلك من التأويلات التي تبقى احتمالاتها قائمة مثل "كائن" أو "موجود".
كذا قال، وهو كلام لا تستسيغه حتى العوامّ، وفيه دلالة بيّنة على أنّه لا يعرف من أساليب العربيّة في الحذف وطرائق تعبيرها شيئاً:
وبيان ذلك أن من عادة العرب أن يحذفوا من الجملة ما هو مفهوم عند السامع، ولا سيّما إنّ كان هذا المحذوف دالاًّ على مطلق الوجود، ولذا نراهم يقولون (لا شكّ في ذلك) فيفهم السامع بلا عناء أنّ المراد: لا شك (موجود) في ذلك. ويقول العربي: الرجل في الدار، فيفهم السامع أيضاً أن المراد: (موجودٌ) في الدار، وقد سمّى النحاة هذا الخبر الملتَزم حذفه (كوناً عامّاً أو مطلقاً)، لأنّه لا يتعلّق بذكره فائدة، ومنه قول جرير:
لولا الحياء لهاجني استعبارُ......فحذف خبرَ المبتدأ بعد (لولا) لأنّه كونٌ مطلق، ولو قال: لولا الحياء موجود, لكان حشواً لا فائدة فيه.
أمّا إذا أراد العربي أن يخبر عن صفةٍ خاصّة كنوم الرجل في داره قال: الرجل نائمٌ في الدار، ملتزماً ذكر الخبر، وإذا أراد أن يخبر عن مرض الطفل قال: الطفل مريضٌ، بلا حذف أيضاً، وإذا أراد أن يخبر أن هذا الطفل مريضٌ، وهو في داره، قال: الطفل مريضٌ في الدار.
وقد سمّى النحاة هذا الخبر الملتزم ذكره (كوناً مقيّداً) لأن السامع لا يُدْركه إلاّ بذكره. وعليه فإن تعليق شبه الجملة بمحذوف تقديره كائن أو موجود لا يكون إلاّ إذا دلّ الخبر على مطلق الوجود، أمّا إذا كان شيئاً مخصوصاً لا يفهم إلاّ بذكره كالمرض والنوم والجلوس والقعود والحزن فلا يجوز حذفه البتّة وعليه فثمة فرق لا يخفى على أحد بين (الطفل في المنزل) و (الطفل سعيدٌ في المنزل). وما توهمه الكاتب أنّ مسجون وحزين وسعيد هي بمنزلة كائن أو موجود إنّما هو تخليطٌ وعبث تنأى عنه ألسنة العرب وأسماع العقلاء من البشر.
-------------------------
-(ماذا) جملة!! لفت الكاتب، على وجه العجب، نظر قارئه إلى أنّ بعض النحاة يعدّوون (ماذا) جملة اسميّة كاملة، مكوّنة من (ما) الاستفهاميّة و (ذا) التي هي اسم إشارة، ثمّ علّق ساخراً: "تأمّل عزيزي القارئ تلك البلاغة، وتأمّل الجملة التامّة التي استوفت شروط المبتدأ والخبر، وتأمّل المدلول العميق الذي يفهمه السامع عندما يقال له (ماذا) أو ما هذا؟".
وقبل أن نستغرق في التأمل نعود إلى تذكير الكاتب أن تراكيب اللغة لا تصاغ في الفراغ، وأنّ لكلّ جملة سياقاً يجب أن تنتظم في سلكه، هذا أوّلاً.
والأمر الآخر الذي أخفاه الكاتب عن قارئه هو أنّ اسم الإشارة يجب أن يتلوه الاسم المشار إليه لأنّ اسم الإشارة مبهمٌ بذاته، لا يدلّ على محدّد، وهذا المشار إليه قد يكون غير مذكورٍ في التركيب اللغوي، لأنّه مفهومٌ عند السامع، فحين يقول أحدنا لصديقه: ما هذا؟ فإنّ المتكلّم والسامع يعرفان الشيء المشار إليه، وبذلك تكون الجملة واضحة المعالم، تامّة، ذات مدلول، بل إنّ هذه الجملة أعرف من قولنا "مَن القادم؟" لأنّ المتكلّم ههنا يجهل القادم، بخلاف الأوّل، فإن المسؤول عنه حاضرٌ مُشَاهَد.
وتعمَّد الكاتب أيضاً أن يحذف (ها) التنبيه التي تقترن عادة باسم الإشارة (ذا)، مع أنّ حذفها في مثل هذا التركيب، أي بعد (ما) الاستفهامية لا يكاد يُعْرَف إلاّ في بيت أو بيتين التقطهما النحاة من شوارد الأشعار.
ثمّ إنّ قوله: "بعض النحاة يعتبرون (ماذا) جملة..." فيه إطلاقٌ وتعمية، لأنّ هؤلاء لا يعدّونها كذلك إلاّ إذا تعيّن أن تكون (ذا) اسم إشارة، وهو أمرٌ نادر أيضاً لم يقع إلاّ في بيت من الشعر أو بيتين مسلّمين بأنّ (ماذا) أكثر ما تستعمل في كلام العرب مركّبة من (ما) الاستفهاميّة و(ذا) الموصوليّة، أو أنّها بتمامها اسم استفهام.
-الأفعال الناقصة:
أقحم الكاتب الأفعال الناقصة في باب الجملة الاسميّة، ولا أدري إن كان هذا من قبيل السهو، أم أنّ عدّها من الجمل الاسميّة هو ضرب من الإصلاح والنقد!! ومهما يكن فقد تناولها من زاويتين:
أ-تسميتها "ناقصة" أمرٌ غريب:
قال: "في التسمية أمرٌ غريبٌ فعلاً، يبينّه المثال (نام زيد) ففعل (نام) هنا تام، في حين أنّ فعل (أمسى) في المثال (أمسى زيد) ناقص".
والحقّ أنّ الغرابة تكمن في طريقته في مسخ الأمثلة ظنّاً منه أنّها تؤدّي إلى ما يرمي إليه من أنّ النحاة وهموا حين قسموا الفعل إلى تامّ وناقص، فما الفرق بين نام وأمسى في المثالين، وكلاهما –في اعتقاده- بمعنىً واحد. هذا إذا أحسّنا الظنّ به وأنه قرأ شيئاً ممّا قاله النحاة في الأفعال الناقصة لكنّه لم يع كلامهم، وإلاّ فما انتهى إليه إنما هو محض افتراء وعبث، إذ لم يقل أيٌّ منهم إنّ (أمسى) في نحو هذا المثال الذي ساقه ناقصة، بل هي تامّة مكتفية بمرفوعها الذي هو فاعل لها، ومدلولها شيء واحد هو الدخول في وقت المساء، نقول: دخلنا دمشق وقد أمسينا، أي صرنا في وقت المساء، أمّا إذا جُعِل معناها في الاسم المنصوب بعدها –وهو الذي غيّبه الكاتب أو غاب عنه- كانت ناقصة، فيقال حينئذٍ: أمسى زيدٌ مريضاً، وغالباً ما تتضمن في هذه الحالة معنى الصيرورة أو التحوّل.
فالفعل أمسى إذاً، شأنه شأن الأفعال الناقصة، له استعمالان: إذا تضمّن معنى الحدث كان تاماً، فيكتفي حينئذٍ بمرفوعه، وإذا كان الحدث لا يظهر إلاّ في الاسم المنصوب بعده، وهو الخبر، عُدَّ ناقصاً.
ب-ما في القرآن يخالف قواعد النحويّين:
فالنحاة زعموا أنّ الأفعال الناقصة ترفع اسماً وتنصب خبراً، ونحن "نجد أنّ القرآن الكريم قد خالف ذلك صراحة، حيث يقول عز وجلّ (فَسُبحانَ الله حين تمسون وحين تصبحون ):
فوقع الفعلان تامّين، خلافاً لما يزعمه النحاة، والسؤال بعد ذلك هو "هل لنا أن نعرف الفرق بين الفعل التامّ والناقص؟ وهنا نجد مَنْ يقول: مهلاً فهذا شذوذ، ولكلّ قاعدة شذوذها، وأنا أقول له: هذا خروجٌ صريحٌ يا سيّدي وليس شذوذاً، شئت أم أبيت، وإنّه ليستوي عندي إذا قلت: كان أحمدُ فائزاً، أو قلت: كان أحمدَ فائزٌ، أو قلت كان أحمدُ فائزٍ، أو قلت: كان أحمدْ فائزْ..".
ولست أدري إن كان هذا الصراخ نقداً يستحق الردّ عليه، ومهما يكن فإن في كلامه سعياً إلى تغييب حقائق اللغة، ومحاولة لقتل القدرة التعبيريّة الهائلة للعربيّة، وفيه أيضاً تجاهلٌ، وربما جهلٌ بجهود النحويين في وصف أحوال هذه اللغة، ولا يخلو أخيراً من مسٍّ بلغة العرب، لغة القرآن الكريم وفصاحتها. فما ذكره أولاً أنّ ما في القرآن مخالفٌ لقواعد النحاة، بدليل مجيء أمسى وأصبح وكان تامّةً = مبنيّ على مغالطة وجهالة، لأنّ قواعد العربيّة إنما شيّدت قبل كل شيء على النّص القرآني، والدارس لقواعد النحاة لا يداخله شكّ في أنّ ما قام به هؤلاء النحاة ما هو إلاّ وصفٌ أمين للغة القرآن، ووقوعُ بعض الأفعال الناقصة تامّة مكتفية بمرفوعها في بعض استعمالاتها أمرٌ لا يقتصر على القرآن وحده بل هو شائعٌ في كلام العرب شعراً ونظماً، وهو أمرٌ عرفه النحاة قبل المؤلّف ورصدوه رصداً دقيقاً، وانتهوا بعد الاستقراء إلى أنّ الأفعال الناقصة تزول عنها هذه الصفة إذا استعملها المتكلّم متضمنّة معنى الحدث، دالّةً على معناها الأصلي الذي وضعت له، والنحاة كما أسلفت هم الذين وقفوا على أمر هذه الأفعال وتبيّنوا أحوالها، وساقوا من الشواهد ما يدلّ على ذلك، وهي شواهد لا شذوذ فيها إلاّ في مخيّلة المؤلّف، بل هي من تمام القاعدة، فانقسام (كان) إلى تامّة وناقصة شيء يعود إلى طبيعة استعمالها في السياق، وهو ضربٌ من الاتساع في التعبير الذي اتسمت به العربيّة، وانقسام (كان) إلى هذين القسمين لا يختلف عن انقسام (رأى) إلى بصريّة تتعدّى إلى مفعول واحد، وقلبيّة تتعدّى إلى مفعولين، ولا يختلف أيضاً عن قولهم إنّ (جَعَل) تُستعمل بمعنى صيَّر فتتعدّى إلى مفعولين، وبمعنى (أنشأ) فتكون فعلاً ناقصاً من أفعال الشروع، وبمعنى (ظنّ).. وبمعنى (وجَدَ)... ومثل هذا كثيرٌ في العربيّة، وهو دليلُ غِنى في وسائل التعبير، لا الشكل.
ولو سلّمنا بمخالفة القرآن لما في القواعد لانتهينا إلى مخالفة القرآن نَفْسَه، لأنّ هذه الأفعال الناقصة استعملت في القرآن ما يزيد على ألف مرّة، منها ما وقعت فيه ناقصة، وهو الأكثر، ومنها ما وقعت فيه تامّة اكتفت بمرفوعها، وعليه فإنّ هذه الأفعال –سيقودنا إليه المؤلف- استعملت بشكل عشوائيّ، مرّة تكتفي بمرفوعها، وأخرى لا تكتفي به بل تحتاج إلى ما يتمّم معناها، وهو المنصوب بعدها، وهكذا فاللغة العربيّة عبثية، وإذاً يجب أن نستبدل بها لغة أخرى (إفرنجية)!!.
أمّا تساؤله عن الفرق بين الناقص والتام من الأفعال فجوابه أنّ مبتدئاً لو سمع قولنا (بات الرجل في الفندق) وقولنا (بات الطريق معبّداً) لأدرك بفطرته الفرق بين الفعلين، وما ذكره أخيراً من أنّ الحركات لا قيمة لها، وإنّه ليستوي عنده... أمرٌ يعنيه وحده، كما قال.
-----------------------------------
إن إصلاح النحو العربي بين الباحثين قد سلك أحد طريقين:
- . إصلاح النحو بإعادة النظر إلى الأصول التي قام عليها.
- . تيسيره وتقريبه من المتعلمين.
ولو تأملنا ما قدّمه كثير من دعاة التجديد وإصلاح النحو العربي لم نرى شيئا ذا بال, وما هي إلا زوبعة في فنجان كما يقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة-رحمه الله- في حديثه حول كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي حين قال:"نحن حريصون على قواعد النحو...لا تعصبا للقديم ولا حبا في التقليد ولا رغبة عن الجديد وإنما حرصنا عليها لأنها الوسيلة لاستقامة ألسنتنا وسلامة أقلامنا, وإن استطاع دعاة التجديد أنّ يبتدعوا لنا قواعد أخف حِمْلا, وأقرب تناولا وأيسر تداولا, تغني غناء قواعد النحو وتسد مسدها, إن استطاعوا ذلك فنحن على استعداد لأن نُقبل عليها, وننصرف عن قواعد النحاة بل وعلى استعداد لأن نلقي كتب النحو في البحر"( النحو بين التجديد و التقليد للأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة (مجلة كلية اللغة العربية. العدد السادس 1396هـ)
-الأحرف المشبّهة بالفعل:
أ-من المضحك قول النحاة: "إذا خُفِّفت (إن) بطل عملها وأصبحت نافية: قال: "علينا أن لا نلوم الطالب ودارس قواعد النحو إذا كان ضعيفاً في فهمه للأمور النحويّة، لأنّها في أصلها لا تستند إلى منطق سويّ سليم، والمضحك أنّ (إنّ) إذا كانت مخففة بطل عملها وأصبحت حرف نفي.. كما في قوله تعالى (وإنْ كلٌّ لَمَا جميع لدينا محضرون( [يس: 32]، فـ إنْ ههنا ليست حرفاً مشبهاً بالفعل، ولكنها [أي في زعم النحاة] إن المخففة تصحو من جديد وتعمل عمل إنّ المشدّدة، كما في قوله تعالى: (علم أن سيكون منكم مرضى( [المزمل: 20]" هذا كلامه، وأقلّ ما يقال فيه أنه افتراءٌ على النحاة، واستخفاف بعقل القارئ وقبْل ذلك دليل جهل بأساليب العربيّة وكلام النحاة، ولا أظنّ عاقلاً فهم من ظاهر عباراته شيئاً، فكيف تكون المخففة نافية، وكيف تصحو لتعمل عمل "إنّ"، وكيف أنها إذا عملت لا تعدّ حرفاً مشبهاً بالفعل...!!
وهنا أراني مضطراً إلى إيضاح ما اختلط في ذهنه من كلام لعلّه قرأه ولم يستوعبه حتى صار هو الآخر "ضعيفاً في فهمه للأمور النحويّة":
لقد أجمع نحاة البصرة على أنّ (إنّ) قد تخفّف في كلام العرب، وانتهوا إلى أنّ الأكثر فيها بعد التخفيف أن تكون غير عاملة، جرياً على المسموع، وقلّة من العرب أبقوها عاملة، وبلغتهم قرأ بعض القراء (وإنْ كُلاًّ لَمَا ليوفينّهم ربُّك أعمالهم( [هود: 11]، إذ خُففت (إنْ) وظلت عاملة عمل المشدّدة. وعند البصريين أنّ هذه الأداة حرف إثبات سواء عملت أم أهملت.أمّا نحاة الكوفة فمذهبهم أنّ هذه الأداة لا تُخفف أصلاً، وما ورد من شواهد زعم البصريون أنّها فيها مخففة مردودٌ بأنها حرف نفي واللام بعدها بمعنى إلاّ. والظاهر أن ما قاله الكوفيون مآله إلى المذهب الأوّل، لأنّ النفي إذا انتقض بـ إلاّ صار إثباتاً. ومما تقدّم نرى أنّ المؤلف خلط بين المذهبين وجعلهما قولاً واحداً فيه ما فيه من الفساد والتناقض، فالقائلون بجواز التخفيف زعموا أنها حرف إثبات (خلافاً لما توهمّه أنّ المخففة نافية). والقائلون إنها أداة نفي أنكروا القول بجواز تخفيفها، أمّا قوله "تصحو من جديد..." فلم يظهر لي منه قصده ولعله يظهر لأحد، والله أعلم.
ثانياً: الجملة الفعليّة:
النحاة حدّدوا المفعول به بناء على الشكل (حركة الآخر) ولم يلتفتوا إلى المعنى:
سلف أنّ المؤلف لم يسأم من تكرار مثل هذا الكلام، ودليله ههنا قول النحاة إن الفعل (جلس) لازم، مع أنّنا نقول "جلس أحمد على السرير" وما من شكّ أنّ فعل الجلوس وقع على السرير، فالسرير إذاً مفعول به، وإن كان مجروراً، "وعليه فإنّه كما نرى لا يوجد ما يُسمّى بالفعل اللازم، وإن لم يقم بنصب الاسم بعده".هذا مجمل كلامه، وفيه دلالة قاطعة على أنّه لم يقرأ عن هذه المسألة في مصنفات النحويين قديماً أو حديثاً، وما قاله أمرٌ يُعرف بالبداهة، لم يخف على أحدٍ من النحاة ولا على أصاغر الطلبة، ولو رجع إلى أيّ كتاب في النحو، لرأى فيه أنّ المفعول به قسمان:
-صريح: هو الذي يتعدّى إليه الفعل بنفسه، نحو: أحبّ وطني.
-وغير صريح:
وهو الذي يتعدّى إليه الفعل مستعيناً بحرف الجر، نحو: جلست في الحديقة، ويسمّى الفعل في هذه الحالة لازماً أو قاصراً أو غير مجاوز، لأنّه لم يصل إلى المفعول به بنفسه، بل بوساطة حرف الجرّ.
تلك هي مصطلحاتهم في اللزوم والتعدّي، ولو أنّهم حدّدوا المفعول به بناءً على حركة الآخر، كما زعم، لما قالوا إنّ لهذا المجرور محلاًّ هو النصب، وأجازوا –نقلاً عن العرب- عطف الاسم المنصوب على هذا المحل، ولو عاد المؤلف إلى سيبويه لوجده يورد البيت:
فإن لم تجد من دون عدنان والداً * * * ودون معدٍّ...
شاهداً على أنّ (دون) اسمٌ معطوف على محل (من دونِ) لأنّ المجرور مفعول به من حيث المحل، ولذا جاز العطف عليه بالنصب.
أليس في هذا دليل آخر على أنّ ما زعمه المؤلف من أنّ النحاة كانوا أسيري الحركات كلامٌ باطل، وافتراءٌ محض، وتجنٍّ بلبوس العقلانية والموضوعية!!
-ليس هناك ما يتعدّى إلى مفعولين:
قال: "أمّا ما يسمّونه الأفعال المتعديّة لمفعولين فإنّه لا يمكن أن يقع الفعل على أكثر من واحد، أي أنه لا يمكن للفعل أن يأخذ أكثر من مفعول واحد، وتلك الأسماء المنصوبة التي سميّت مفعولاً به ثانياً.. ضربٌ من التخريجات لحركة النصب التي ارتبطت دائماً في ذهننا بالمفعول به" فإذا قلت: أعطى أحمد الفقير رغيف خبز "فالحقيقة أنّ الذي وقع عليه فعل العطاء أو المنح هو "الفقير"، أمّا الرغيف فهو ليس مفعولاً به ثانياً، وهو يبيّن نوع العطاء، ولا علاقة له بوقوعه" وإذا قلت: أظنّ الطالب ناجحاً "فإن فعل الظن وقع على الطالب ولم يقع على نجاحه، وكلمة (ناجحاً) تبيّن حال الطالب وتتعلّق به، ولا علاقة لها بفعل الظنّ".وهذا الذي انتهى إليه المؤلّف رأي نقبله على أنّه من النقد، وإن كان يفتقر إلى الدقّة، ولو رجع إلى ما قاله النحاة في درسهم لهذه الأفعال لوجد كلامهم أقرب إلى الصواب، قال الرضي: "باب كسوت وأعطيت متعدٍّ إلى مفعولين في الحقيقة، لكنّ أوّلهما مفعول هذا الفعل الظاهر، إذ (زيدٌ) في قولك: كسوت زيداً جبّة وأعطيت زيداً جبّة =مكسوٍّ ومعطىً، وثانيهما مفعول مطاوع هذا الفعل، إذ الجبّة مكتساة ومعطوّة، أي مأخوذة". "وأفعال القلوب [ظنّ وأخواتها] في الحقيقة لا تتعدّى إلاّ إلى مفعول واحد، هو مضمون الجزء الثاني مضافاً إلى الأوّل، فالمعلوم في (علمت زيداً قائماً) قيامُ زيد، لكن نصبهما معاً لتعلّقه بمضمونهما معاً".
ولو اطّلع المؤلّف على مثل هذا الكلام لكان أكثر دقّة في كلامه، ولما أطلق الردّ على النحاة، وأمّا قوله إن حركة النصب ارتبطت في ذهننا دائماً بالمفعول به، ففيه تعميم، والصحيح في ذهنه وحده، وإلاّ فهي ترتبط في أذهاننا بسائر المنصوبات كالحال والتمييز والظرف والمفعول به.
-انقسام الفعل إلى مجرّد ومزيد فيه خَلْطٌ ومغالطة..
قال: "وهنا أيضاً نجد أنفسنا أمام خلط ومغالطة وشدّ وعصر للمعطيات والحقائق، فالفعل المزيد (كاتَبَ) مثلاً إذا حذفنا منه الألف المزيدة –حسب رأيهم- نحصل على الفعل (كتب)، وهو مغايرٌ تماماً في معناه للفعل (كاتَبَ)، وفي كلّ الأحوال فإنّه لا يمكننا إسقاط أيّ من الحروف في الأفعال، سواء كانت مجردة أم مزيدة، لأنّه لا ترادف في مفردات اللغة" كذا قال، وفيه تخليطٌ عجيب وتجنّ على النحويّين، وعدم استبانة مقاصدهم من درس الزائد والأصليّ من الحروف، وهي تتبّع القيم التعبيريّة للحروف الزوائد في بنية الكلمة، فهم من خلال هذا الدرس تتبعوا مثلاً معاني الأبنية في العربيّة، بعد أن تهدّوا إلى الأصل العام الذي تنتظم تحته حروف الزيادة، وهو أنّ كلّ زيادة في المبنى تستدعي زيادة في المعنى، فـ استغفر ليس بمعنى غفر، وكسب ليس مرادفاً لـ اكتسب، وقاتل يختلف عن قتل، وكسَّر لا يساوي كَسَر.. وأوّل درجات هذه المعرفة هي تبيّن الزائد من الأصلي، وإلاّ فكيف ندرس معاني حروف الزيادة إن كان المؤلّف لا يريد أن نفرّق بين الزائد والأصلي، ولا أظنّ أحداً يخفى عليه أنّ الاشتقاق في العربيّة، وهو أظهر سمة في بنيتها الداخليّة يقوم على معرفة الزائد والأصلي. أما ما فهمه من صنع النحاة فلا يرضى به مبتدئ، والمغالطة بيّنة في كلامه حين استعمل عبارة (حذف) و (إسقاط) و (ترادف) فالنحاة لم يسقطوا شيئاً ولا ادّعوا حذف شيء، وهم الذين فرّقوا بين كسب واكتسب، فأين الترادف؟، وهم مدركون كلّ الإدراك لطبيعة العربيّة التي تقوم بنية ألفاظها على ما يسمّى الأصل اللغوي أو الجذر، وهذا الأصل أشبه ما يكون بجذع الشجرة، وحروف الزيادة إنّما هي فروعٌ تعلو على الجذع وتتصل به، فقولنا (ك ت ب) هو الأصل، وبمعرفة حروف الزيادة استطاع متكلمو العربيّة أن يشتقوا نحو: كاتب- مكتوب- كتاب- كتيّب- استكتب- مكتب- مكاتبة...والمؤلف يسمّي، بلا تردّد، معرفة هذا "خلط، ومغالطة، وشدّ، وعصر للمعطيات والحقائق" ويريدنا ألاّ نبصر شيئاً من هذه الحركة الداخليّة لبنية الكلمة!! فهل بعد هذا الجهل جهل!!!؟